
مشكلة واشنطن في الردع الذاتي في سوريا… بقلم جيمس جيفري

في الوقت الذي يقوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بزيارة ألمانيا للمشاركة في مؤتمر الأمن الثاني والخمسين الذي يُعقد في ميونيخ هذا الأسبوع، تتزايد الأسئلة المطروحة حول سياسة واشنطن المترددة في سوريا. فخلال شهادته أمام “لجنة الخدمات المسلحة” في مجلس الشيوخ الأمريكي في 9 كانون الأول/ ديسمبر، أكد وزير الدفاع الأمريكي آش كارتر ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال بول سيلفا الفكرة على أن إدارة الرئيس أوباما “ردعت نفسها” بشكل فعّال عن اتخاذ إجراءات أكثر قوة في الحرب، بما في ذلك التحرك الموصى به كثيراً، وهو إقامة ملاذ آمن في شمال سوريا. وكما قال سيلفا، “لدينا القدرة العسكرية لفرض منطقة حظر جوي. لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه هو: هل لدينا خلفية سياسية وسياسات للقيام بذلك؟”
وكانت الإجابة حتى الآن بالنفي. فبين حملة موسكو الضخمة والقصف العشوائي منذ أيلول/سبتمبر والنجاحات الناتجة عن التحالف السوري-الإيراني-الروسي في الأسبوعين الماضيين، لم تتخذ إدارة أوباما أي إجراء عسكري أو سياسي فعّال لمواجهة تحركات الكرملين. وفي حين لم تكن المواجهة المباشرة لتشكل خطوة حكيمة، إلا أن الردود الأمريكية التقليدية لمثل هذه الاستفزازات عادة ما كانت تشمل انتشاراً عسكرياً للتفاخر، وخطوات ملموسة لإحباط النصر العسكري الروسي، وجهود لطمأنة الحلفاء من خلال “وجود” أمريكي. ومع ذلك، لم تتم أي خطوة من هذا القبيل خلال تدخل موسكو في سوريا. وبدلاً من ذلك، يبدو أن الإدارة الأمريكية قد ردعت نفسها عن اتخاذ التدابير، الأمر الذي أدى إلى تأثيرات مأساوية على الحرب وآثار من المحتمل أن تكون خطرة على نظام الأمن العالمي الأمريكي بأكمله.
إن آخر التطورات، وعلى وجه التحديد تعليق محادثات جنيف للسلام، والهجوم الكاسح من قبل “المحور” الروسي للسيطرة على حلب وهزيمة المعارضة في المحافظات الغربية المكتظة بالسكان، توجه ضربة مريرة لاستراتيجية الإدارة الأمريكية المعلنة التي تقوم على السعي إلى الإطاحة بالأسد وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الصراعات بين السنّة والشيعة. بيد أن ذلك يشكل خطراً على نطاق أوسع بكثير وهو: سلامة العلاقات الأمنية الأمريكية في المنطقة منذ السبعينيات. إن السرعة التي حققت فيها روسيا ونظام الأسد وحلفاؤهما من الميليشيات الشيعية بقيادة إيران النجاح على الأرض، إلى جانب عدم قدرة واشنطن على لعب دورها التقليدي في فرض التوازن العسكري، جميعها عوامل قد تؤدي إلى الحد من ثقة الأطراف الأخرى بالولايات المتحدة، خاصة في ظل حملتها العسكرية البطيئة والخجولة تقريباً ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»). فكما صرّح أحد المسؤولين في الولايات المتحدة لصحيفة “ديلي بيست” في 7 شباط/ فبراير، إن المنهجيات المختلفة التي تعتمدها كل من موسكو وواشنطن “تظهر للمنطقة من هي الأطراف المشاركة [في سوريا]. فالولايات المتحدة عاجزة بينما روسيا وإيران حليفان موثوق بهما”.
سيعمل المحللون مطولاً على تحديد الخطوات التي أوصلت الولايات المتحدة إلى هذا المأزق. فحالة الاختلال الخطرة في المنطقة تتحمل نصيباً من اللوم، وكذلك الارتياب العام للرئيس أوباما تجاه استخدام القوة. بيد، يقع غالبية اللوم على عاتق الإدارة الأمريكية بردة فعلها التي تقوم على ردع النفس تجاه فرض السلطة الروسية في ساحة أمنية أمريكية تقليدياً. فبشكل فوري بعد أن دخلت القوات الروسية سوريا في الخريف الماضي، أكد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لن تدخل في مواجهة مباشرة مع موسكو في سوريا. وبدلاً من ذلك، تطرق باستخفاف إلى عملية التدخل، واصفاً إياها بأنها تشكل مأزقاً للقوات الروسية وبالتالي أعفى نفسه من الحاجة إلى القيام بأي خطوة. إلا أنه لم يحدد كيف سيرد على الطائرات الروسية التي تستهدف فصائل الثوار التي تدعمهم الولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك، رفض مفهوم العمل على نطاق أوسع، والذي من المفترض أن يشمل منطقة حظر جوي أو منطقة عازلة، بلغة مربكة بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يعرفون عمّا يتحدثون عنه.
وفي النهاية، نشرت الإدارة الأمريكية مقاتلات جو- جو من طراز “إف 15” في قاعدة إنجرليك الجوية جنوب تركيا. لكن في الوقت نفسه تقريباً سحبت وحدات صواريخ أرض-جو من طراز “باتريوت” الأمريكية التي كانت قد نشرتها في تركيا تحت قيادة “حلف شمال الأطلسي” (“الناتو”) منذ عام 2012 في استجابة إلى الأزمة السورية (على الرغم من الإبقاء على صواريخ “باترويت” التابعة لوحدات “حلف شمال الأطلسي” الأخرى). وبعد ذلك بوقت قصير، تم كذلك سحب صواريخ “إف 15”.
بالإضافة إلى ذلك إن رد فعل الولايات المتحدة على إسقاط تركيا لطائرة روسية في تشرين الثاني/ نوفمبر سلط الضوء أيضاً على قلق الإدارة الأمريكية الكبير تجاه تجنب الحوادث. ففي حين أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر بـ “أننا نقف إلى جانب تركيا كحليف في حلف شمال الأطلسي”، شدد الرئيس أوباما على ضرورة التخفيف من عملية التصعيد. ويقيناً، إن بعض أسباب الحذر مفهومة نظراً إلى خطورة هذا الوضع، كما أن الحكمة السياسية الكامنة وراء الخطوة التي اتخذتها أنقرة مشكوك فيها. بيد أن الحادث كان نتيجة توغل روسي في محافظة تركية لطالما طالب بها النظام السوري، حليف موسكو. وفي ضوء المبررات القانونية التي قدمتها أنقرة والمسؤولية التي تقع على عاتق روسيا لدخول منطقة حساسة ومكانة تركيا في “حلف شمال الأطلسي”، كانت استجابة الولايات المتحدة فاترة على أبعد تقدير.
وفي هذا السياق، لم يكن تصريح الجنرال سيلفا في كانون الأول/ ديسمبر بالمفاجأة. وحول الجدوى العسكرية من إقامة منطقة عازلة في الشمال، تساءل: “هل يمكن لنا أن نفعل ذلك؟ الجواب هو نعم. هل نحن على استعداد للانخراط في… صراع مباشر محتمل مع نظام الدفاع الجوي السوري المتكامل أو بشكل بديهي، في سوء تقدير مع الروس إذا اختاروا خرق منطقة الحظر الجوي؟ لا بد من أخذ عواقب النشاط من أنظمة صواريخ أرض-جو وطائرات الدفاع الجوي بعين الاعتبار في هذه المعادلة. إذ لدينا القدرة على التعامل معها. النتيجة ستكون مواجهة مباشرة مع روسيا أو سوريا”. وفي كانون الثاني/ يناير وأمام لجنة مجلس الشيوخ نفسها، قام عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي السابق فيليب غوردون، والذي غالباً ما يوجه تفكير الإدارة الأمريكية، بإكمال الردع الذاتي العسكري الذي تحدث عنه سيلفا مع جرعة من الردع الذاتي السياسي. وبعد أن أعلن أن “أي سلام تقريباً في سوريا سيكون أفضل من الحرب الحالية”، لم يستبعد فقط التدخل الأمريكي المباشر بل قدم الحجج ضد زيادة الدعم للثوار. “نظراً إلى الالتزام الروسي والإيراني القوي في دعم النظام”، أعتَبر أن “مثل هذا التصعيد سيؤدي إلى تصعيد مضاد جديد [من قبل الطرف الآخر]”.
يشكل الردع الحقيقي عقبة أمام التحرك يمكن فهمها أكثر من “الردع الذاتي”. فعندما يتمتع العدو بالتفوق في القوة وبالمصالح السياسية التي تشكل الأولوية في وضع ما، أي القدرات والنوايا وهما العاملان العسكريان والجيوستراتيجيان الرئيسيان للتحرك، فإن الردع يكون حقيقياً، متأتياً من الجانب الآخر وليس ردعاً يفرضه الطرف على نفسه. وتشمل الأمثلة على ذلك تحركات روسيا في شبه جزيرة القرم، وإلى حد ما، في بكين في بحر الصين الجنوبي. وتبرز حدود حقيقية لما يمكن أن تفعله واشنطن لمواجهة مثل هذه الأعمال، ورغم أنها غير شرعية، لأن الحكومات المعنية ترى تلك المناطق ضرورية لمصالحها، إلا أن لديها نية واضحة في الدفاع عنها والقدرة العسكرية للقيام بذلك حتى ضد الولايات المتحدة، ناهيك عن حرب تستخدم فيها كافة القدرات.
لكن من الواضح أن هذا ليس هو الحال في سوريا أيضاً. فروسيا لديها مصالح مشروعة هناك، وأبرزها علاقة طويلة الأمد مع نظام الأسد وقاعدة بحرية على الساحل السوري. إلا أن هذه المصالح محدودة مقارنة مع المصالح الأمريكية. فبينما لا تتمتع سوريا نفسها بأهمية حاسمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، إلا أنها تقع وسط منطقة أمنية هامة جداً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وهي منطقة تشمل أحد أقوى حلفاء واشنطن في “حلف شمال الأطلسي”، أي تركيا الواقعة شمال سوريا فضلاً عن أنها تشمل أقرب أصدقاءها، أي إسرائيل جنوباً. كما تقع دولتان من الشركاء الأمنيين الوثيقين على الحدود السورية هما الأردن والعراق. بالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة العربية السعودية وغيرها من الشركاء الرئيسيين في الخليج إلى جانب أنقرة، والأردن إلى حد ما، جميعها تدعم المعارضة السورية، وغالبيتها تعتبر أن الحرب تشكل التحدي الأمني الرئيسي في المنطقة. وقد دعت واشنطن نفسها إلى رحيل الأسد منذ عام 2011، ودعمت شركاءها في مساعدة جماعات الثوار، وأجرت عمليات تدريب وتجهيز قامت بها “وكالة الاستخبارات المركزية” الأمريكية في الأردن. وعلى نطاق أوسع، لعبت الولايات المتحدة دوراً بارزاً في أمن الشرق الأوسط منذ السبعينيات، وردت على التحركات الروسية هناك في عام 1973 وعام 1980. وبالتالي، من المفترض أن الولايات المتحدة تنوي حماية هذا المركز الهام.
من الواضح أنها تتمتع بالقدرة العسكرية للقيام بذلك، كما أشار الجنرال سيلفا. وفي البداية تدخلت روسيا من خلال أربعة وثلاثين طائرة مقاتلة فقط وعدد قليل من الطائرات المروحية. فالسلاح الجوي السوري لم يعد فعّالاً في المعارك ولا يمكن لإيران أن تستخدم قوتها الجوية إلى هذا الحد البعيد. إلا أن الولايات المتحدة عادة ما يكون لديها 150 إلى 200 طائرة مقاتلة في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن لدى كل شريك من شركائها الأربعة القريبين (تركيا والسعودية وإسرائيل ومصر) 200 إلى 300 طائرة على الأقل لكل منها، بالإضافة إلى 100 طائرة يملكها الأردن. وبطبيعة الحال أن أنظمة الدفاع الجوي السورية والروسية تشكل تهديداً ولكن كما أشار الجنرال سيلفا، يمكن للقوات الأمريكية التعامل معها. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الطائرات الروسية صواريخ “باتريوت” التابعة لـ”حلف شمال الأطلسي” في جنوب تركيا وصواريخ “باتريوت” إضافية في إسرائيل وأنظمة رادار متقدمة أمريكية إلى جنوب سوريا ومنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي “ايجيس” ذات القدرة العالية على السفن قبالة الساحل.
بعبارة أخرى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الذي وضع نفسه في وضع خطر للغاية حيث كان ميزان القوى يميل بشكل كبير ضده، وحيث يُفترض أن الولايات المتحدة تتمتع بنيّة تامة للتصدي له. إلا أنه يبدو أنه فاز برهانه، وذلك ليس لأن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على التحرك، بل لأن واشنطن رأت أن ذلك يحمل في طياته مخاطرة كبرى.
ليس هناك شك في أن التلاعب مع قوة نووية دائماً ما يحمل في طياته مخاطر [غير مرغوبة]، ولكن من المؤكد أن بوتين كان يدرك ذلك عندما تدخل في منطقة أمنية أمريكية. فالولايات المتحدة لم تدع مثل هذه المخاطر تردعها عن رد فعل على التحركات الروسية في كوبا في عام 1962، وفي منطقة الشرق الأوسط في العقود اللاحقة، أو في أمريكا الوسطى في الثمانينات. لكن اليوم تميل واشنطن إلى ردع النفس حتى في المواجهات مع القوى غير النووية، كما رأينا في تحذيرات الرئيس أوباما المتكررة من أن تصعيد الحملة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» يمكن أن يوقع “الآلاف من الضحايا” ويؤدي إلى حرب عراقية أخرى، وإلى عقد من التزام القوات [بالبقاء في العراق].
وتنبع هذه الاستنتاجات عن هذه الملاحظات. أولاً، بعد “تردد” الولايات المتحدة على الرغم من تفوقها العسكري الساحق، ستواجه واشنطن صعوبة في الرد حالياً بينما يبدو أن روسيا تنتقل من نصر إلى آخر في سوريا، وستتزايد الصعوبة بصورة أكثر كلما طال انتظار واشنطن. ثانياً، إذا كان بإمكان بوتين أن يفلت من الرد على هذه الأنشطة في سوريا، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو، أين ستكون عمليته المقبلة، سواء كان يتمتع بالتفوق العسكري أم لا؟ وإذا فشل الردع الأمريكي في مكان واحد بسبب الافتقار إلى الإرادة والنية، فهل سينجح في أي مكان آخر؟ ثالثاً، ما الذي سيحدث إذا أخطأ بوتين في الحسابات ووقع في خطأ فاضح في منطقة ما بحيث حتى الرئيس أوباما يشعر بأنه مضطر على العمل فيها؟ وتظهر هذه الأسئلة كيف يؤدي التقاعس المستمر إلى زيادة الخطر على المصالح الأمريكية ونظام الأمن الدولي، وليس كما تعتقد الإدارة الأمريكية يحول دونها.
جيمس جيفري هو زميل متميز في زمالة “فيليب سولوندز” في معهد واشنطن وسفير الولايات المتحدة السابق في العراق وتركيا.
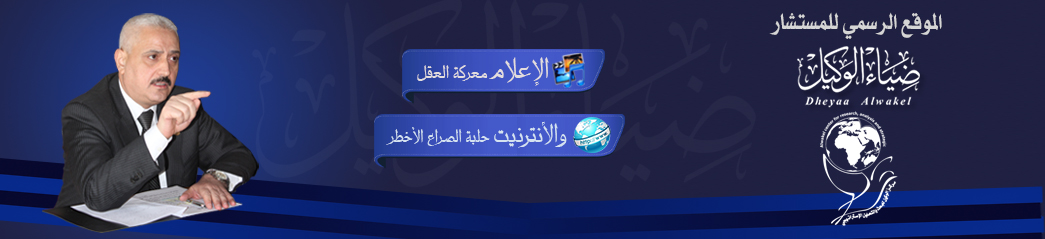 المستشار ضياء الوكيل
المستشار ضياء الوكيل



