
((يعتمد نجاح أي خطة لمكافحة التطرّف، أولاً، على التشخيص السليم للأسباب التي تؤدّي إلى التطرّف، وثانياً على الإرادة السياسية لمعالجة هذه الأسباب بطريقةٍ منهجية ومستدامة))….
تعكف الحكومة هذه الأيام على بلورة خطة لمكافحة التطرّف الذي بدأ ينتشر داخلنا، خاصة بين فئة الشباب. وقد أظهرت استطلاعات عدة أن التأييد لمنظمات إرهابية كداعش مثلا، يصل إلى عدة مئات من الألوف، ما يستدعي انتباها ومعالجة جدية لهذه الظاهرة.
إن نجاح أي خطة لمكافحة التطرّف يعتمد، أولا، على التشخيص السليم للأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا التطرّف. كما يعتمد، ثانيا، على الإرادة السياسية لمعالجة هذه الأسباب معالجة منهجية ومستدامة.
وقد أظهرت التجارب الماضية أن معظم الخطط كانت تركز على الحملات الدعائية، من شاكلة شعارات تُرفع على لوحات الإعلانات، أو تبث على شاشة التلفزيون، كأن الموضوع يتعلق بحملة دعاية ولا يتعلق بما هو أعمق من ذلك؛ من فشل لسياسات اعتُمدت لعقود، وأدى جزء منها إلى الإحباط الذي يشعر به البعض. وفي علم التسويق، هناك قاعدة أساسية تقول إنه لا يمكن تغليف ما ليس موجودا على الرف؛ فإما أن نكون مستعدين لتعديل السياسات بما يتوافق مع معالجة أسباب التطرّف، ومن ثم اعتماد الوسائل التسويقية الكفيلة بشرح هذه السياسات للناس، أو سنصرف جهدا ومالا مرة أخرى لحملة تسويقية لما هو ليس موجودا، وبالتالي نضمن فشل الخطة.
يجب أن تعترف أي خطة لمكافحة التطرّف بحجم فجوة الثقة بين المواطن والدولة، وضرورة تجسير هذه الفجوة. إذ هناك شعور عارم في البلد أن الحكومة باتت ليست صاحبة الولاية العامة؛ وأن هيكلية قوانين الانتخاب، كما تدخل مؤسسات في الدولة بعمل المجالس النيابية، أديا لقناعة عريضة بأن مجالس النواب ضعيفة، وبالتالي أن صوت المواطن ليس ممثلا أو مسموعا. هذا ليس في صالح الدولة. ونذكر جميعا كيف كان الاقتناع لدى المواطن العادي بأن مجلس نواب العام 1989 كان ممثلا ومنتخبا بحرية، عاملا أساسيا في تجنيب البلاد الصعوبات السياسية والاقتصادية التي رافقت حرب الخليج الأولى في العام 1991. وللأسف، ينضم اليوم بعض الشباب لمنظمات كداعش ليس إيمانا بأيديولوجية همجية إقصائية، بقدر شعورهم أن “داعش” يعطيهم صوتا مسموعا.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد حان الوقت لاستراتيجية اقتصادية عمادها إيجاد فرص عمل للشباب، عن طريق خلق جو استثماري جديد يعتمد على القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع وجود إرادة سياسية لتذليل العقبات التي تعترض ذلك، خاصة من قبل إدارة حكومية أصابها الترهل بسبب كبر حجمها، وطبقة سياسية تقف في طريق التحول الاقتصادي حتى لا تخسر امتيازاتها. لن تقنع الخطط الاقتصادية أحدا بعد اليوم إن لم تنجح في تخفيض البطالة، بعد أن فشلت كل الخطط على مدى العقود الماضية في تحقيق ذلك.
وقبل وبعد كل ذلك، لا بد من اعتماد استراتيجية تربوية عمادها قبول الآخر واحترام التنوع. وما تزال وزارة التربية والتعليم ترفض الاعتراف بالمشكلة، خاصة حين تفتقر مناهجنا لذكر الأمثلة الإيجابية على هذا التنوع، من شاكلة الإشارة مثلا للشخصيات التي ساهمت في بناء هذا البلد من شركس ومسيحيين ومسلمين ونساء ورجال ممن كانوا كلهم مثالا على المواطنة الصالحة التي تخدم البلد، بالرغم من تنوعهم الفكري والإثني والجندري والطائفي.
حين تضطر دائرة الافتاء لإصدار فتوى تجيز تعزية “غير المسلمين”، ندرك حجم الأذى الذي لحق بمجتمعنا من قبل تيار الجهل والتكفير، الذي لا ينظر إلى أخيه أو أخته نظرة المواطنة المتساوية، ويريد هدم بنيان التعايش النموذج الذي ميز هذا البلد منذ القدم. تعليم احترام التنوع جزء أساسي من أي خطة ناجعة لمكافحة التطرّف.
هذه حقائق لا يريد الكثيرون مواجهتها. إن أردنا بناء مجتمع تعددي مسالم مزدهر غير متطرف، لا بد من معالجة الأسباب الحقيقية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف. عدا ذلك، لن يتعدى الجهد بيع الأوهام.
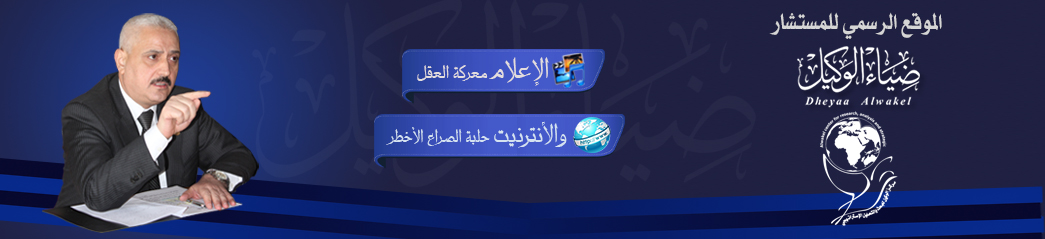 المستشار ضياء الوكيل
المستشار ضياء الوكيل



