
ليست الحروب جديدة في اليمن، ولا العنف كذلك، ولا حتى محاولة السيطرة على البلد من خارج إطار السلطة. لكن المختلف هذه المرة أن المعركة هي بين طرفين (أو أكثر) يمتلكون جميعهم دوافع غير وطنية. فعلى الرغم من أن أحدهما شرعي والآخر غير شرعي، وفقاً للمعطيات الدستورية وكل الأسس والمرجعيات الرسمية، إلا أن كليهما غير وطني.
ولعل الأهم من ذلك أن ما يجمع هذه الأطراف، من عبد الملك الحوثي إلى عبد ربه منصور هادي إلى علي عبد الله صالح، هو في الواقع أكثر مما يفرّقهم. وينطبق ذلك بدرجات مختلفة على أنصارهم وبعض حلفائهم.
لقد أسهم كل طرف، وإن بأقدار متفاوتة، بسلوكيات تمزق اليمن، كلٌ بطريقته، ولأهدافه ومصالحه الخاصة. وخلال السنوات الماضية عقدت صفقات عدة بينهم، أدّى جلّها إلى التناوب على تدمير اليمن الربح من تيك توك.
الخارج يُشعل الحرب؟
تنطبق المعادلة نفسها على الفاعلين الإقليميين والدوليين. فمشكلة البلاد ليست مع أبنائها فحسب، ولكن أيضاً مع “أصدقائها”. فالمملكة العربية السعودية لا تحارب في اليمن من أجل اليمن، كما تحاول إيران، كخصم إقليمي للسعودية، استغلال اليمن واستخدامه لتوظيفه في صراعاتها في المنطقة، وهي تراه بيئة منخفضة الثمن لاستدراج دول الخليج كافة إلى حلبة صراع استنزافي بلا حكَم. وبالنسبة للدول الغربية، فهي فرصة تاريخية لتجريب أحدث الأسلحة الذكية وعقد صفقات أسلحة بأرقام فلكية، وفرصة هائلة للشركات الأمنية الخاصة. المهمّ إدراكه هنا هو أن الغرب والإقليم غير مستعدَّين لخوض هذه الحرب إلى النهاية، أو حتى إلى أن يتحقق انتصار لأي من الطرفين، وهو أمر يزيد (حتى من وجهة نظر برغماتية وليس فقط أخلاقية ووطنية) من أهمية رفض هذه الحرب والعمل على التعجيل بإنهائها. يمكن أن يُقال الكثير عن دور الخارج في إشعال اليمن، ودوره حالياً في إشعال هذه الحرب وتجاهلها في آن، إلا أنها في نهاية المطاف حرب كانت مسبّباتها يمنية، وكذلك هي أطرافها التي سمحت للخارج بلعب هذا الدور، لغياب الحس والأجندة الوطنيين لديها.
التمحيص في المتغيّرات منذ 2011 يشكل منطلقاً مهماً لبلورة الموقف، وقبل ذلك، لفهم ما حدث لليمن السعيد الذي عاش أهم ثورة سلميّة في العالم العربي، ثورة سلمية بامتياز بالنظر إلى كمية الأسلحة التي تفوق 68 مليون قطعة سلاح في حوزة الأشخاص وحدهم. لكن العالم والإقليم، وبتواطؤ من الأطراف المحلية، صدّوا التغيير السلمي، ومنحوا علي عبد الله صالح ونظامه حصانة غير مشروطة، آخذين اليمن إلى مسار قسري تتداوله الميليشيات.
كانت “المبادرة الخليجية”، مع تلك الحصانة غير المشروطة التي تضمّنتها، ومع احتيالها على عملية التغيير في اليمن، هي أول انقلاب علني على أحلام اليمنيين وعلى فكرة السلام. ومع أنّه كان بإمكان المبادرة بكل شوائبها أن تؤسّس الأرضية لعملية تغيير آمنة وطويلة المدى، إلا أن درجة التزام رعاتها وأطرافها، وجديتهم، كانت منخفضة ولم تنعكس عبر سياسات تحمي البلاد من التفكّك وتحقق الحد الأدنى مما يمكن تحقيقه. بل على العكس من ذلك، فهي أسّست، عبر خطوات عملية ممنهجة ومنظمة، إلى “ملشنة” (نسبة إلى ميليشيا) اليمن وإلى تشظّيه وتمزّقه. وفي هذا الفصل الأول للانقلاب، كانت جميع الأطراف التي تتقاتل الآن باليمنيين، متوائمة في عملية الفساد والإفساد. وبالتراضي بينها احتالت على الجنوب والشمال وكل القضايا.. وبقصد استقطابها، استمرّت دول الخليج في الدعم السياسي والمالي للأطراف المحلية، خارج إطار السلطة، بما يتنافى مع ما أعلنته المبادرة الخليجية كهدف. واختارت كل دولة الطرف الذي يتقارب مع أفكارها ومصالحها.
التداول السلمي للفساد
في شباط/ فبراير 2014، بدأت الحلقة الثانية من سلسلة “الانقلابات” في اليمن، إذ مدّد أعضاء “الحوار الوطني”، دون امتلاكهم لأي صفة دستورية، الفترة الرئاسية للرئيس هادي لعام آخر، بعد وعده لهم علناً وأمام الكاميرات بأنه سيعيّنهم في هيئات “مخرَجات الحوار الوطني” بمجرد إنهائهم مؤتمر الحوار الوطني والموافقة على مخرجاته والتمديد له لعام آخر، في واحدة من أوقح عمليات الرشوة العلنية في التاريخ. وفي عملية تصويت تهريجية بالوقوف، صرخ الحاضرون “فوّضناك”! وبالطبع رحّب المجتمع الدولي بهذا التهريج والتمديد للفشل والكارثة والغنائمية غير الدستورية.
لم تكن المشكلة تقتصر على التمديد للرئيس هادي، فذلك أمر يمكن الجدل حوله بل وحتى تفهّمه، خاصة أن الفترة الانتقالية الزمنية كانت بالفعل غير كافية لتحقيق كل ما وعدتْ به. إلا أن التمديد ذاك لم يرتبط بأي جدول أعمال أو أجندة وطنية أو خارطة طريق، باستثناء التغانم المشترك للمناصب بين الأطراف القديمة والجديدة، والتداول السلمي للفساد الذي تمّ بين هادي وعلي عبد الله صالح وأحزاب “اللقاء المشترك” بقيادة “التجمع اليمني للإصلاح” وما تبقى من “الحزب الاشتراكي اليمني”: صفقة التمديد لمجرّد التمديد وليس لإنجاز مستحقات لم تُنجز.
وكانت السفسطة الدولية شريكاً فعالاً في استمرار هذا “اللامشروع” الذي مهّد لنشوء وسطوة الميليشيات، ولصراع إقليمي (بدأ سعودي ــ إيراني وتطوّر حتى وصل إلى داخل البيت الخليجي نفسه). وأصدر مجلس الأمن الدولي بياناً قال فيه إن “المبادرة الخليجية” في اليمن مرتبطة بالتنفيذ وليس بأي جدول زمني. وهكذا بدأ فتح الوقت بدلاً من الضائع، ليصبح كل الوقت في اليمن ضائعاً ومُهْدراً وقاتلاً.
انقلاب على لقمة العيش
في تموز/ يوليو من العام نفسه، جرى انقلاب من نوع آخر: هذه المرّة ليس على أحلام اليمنيين وآمالهم بالتغيير، بل على لقمة عيشهم، بالإمعان بإفقارهم وإذلالهم وتجويعهم لصالح نخبة محدودة. أصبح ما يقارب من 12 مليون يمني (ما يقارب نصف اليمنيين!) بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. ومع ذلك، أصدر الرئيس هادي حينها قراراً برفع الدعم عن المشتقات النفطية بناء على توصية من صندوق النقد والبنك الدوليين، سوّغها وتبنّاها مسؤولون اقتصاديون نيوليبراليون، من تيار الغنائمية الاقتصادية المتصاعدة في اليمن.
لم تكن شناعة ذلك القرار مرتبطة فحسب بالأوضاع المعيشية الصعبة لأغلب اليمنيين، بل بكونها قرارات ليست ناتجة عن أية دراسة أو حاجة مالية حقيقية للرئيس وحكومته. كانت المساعدات الأجنبية (التي رُفع الدعم عن المشتقات من أجل الحصول عليها) في العام 2012 تصل إلى 6 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلد. وفي العام 2013 قال تقرير للمعهد الملكي للشؤون الدولية (شاتام هاوس) إن عشر عائلات في اليمن تسيطر على أكثر من 80 في المئة من الواردات والتصنيع والتجهيزات والخدمات المصرفية والاتصالات ونقل البضائع (من الإبرة إلى الدبابة)، في تلخيص مرعب لتكدس الثروة عند قلة. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014، نقلت مجلة “فورين بوليسي” أن الرئيس اليمني هادي قد حصل على ما يقرب من 4 مليارات دولار من السعودية منذ العام 2012، كمساعدات نفطية وللضمان الاجتماعي للفئات الأفقر، إضافة إلى مئات الملايين من الدولارات من قطر لدعم “لجنة الأراضي والمبعَدين” في جنوب البلاد، مضيفة أن جميع هذه الأموال ذهبت في “ثقب أسود”، باستيلاء أقارب الرئيس هادي عليها. وتشير مذكرة للسفير السعودي في صنعاء إلى أن الشحنات النفطية التي قدّمتها السعودية في العام نفسه لم ترد أثمانها إلى خزينة الدولة اليمنية.
كان ذلك القرار برفع الدعم عن المشتقات النفطية (الذي يصرّ رئيس الوزراء حينها، محمد سالم باسندوة، بأنه اتُخذ من الرئيس هادي دون أي تشاور معه) بمثابة القشة التي قصمت ظهر اليمني العادي، إذ ارتفع ثمن البنزين ما يقارب الضعف، فاشتعلت الأسعار وأشعلها الحوثيون بدورهم. اندلعت مظاهرات في عموم البلاد رفضاً لهذا القرار غير المدروس وغير المرتبط بإصلاحات باستثناء تخمة التوافق السياسي بين جميع الأطراف مقابل اللامبالاة بما يحصل لـ26 مليون يمني. امتطى الحوثيون ببنادقهم كل هذه المظالم، لاعبين على الفراغ: التناغم المطلق لشلة الفساد بمقابل خلوّ الساحة من أي مشروع سياسي يعبّر عن الناس. انطلقوا من الدفاع عن حقوق العامة ومصالحهم، في وقت تحوّلت فيه كل القوى الأخرى إلى “سلطة”، ولم يقف في مربع المعارضة سواهم.
.. إلى الانقلاب الأكبر
أغلب ما جرى من سياقات سياسية منذ توقيع المبادرة الخليجية كان مختلاً واحتيالياً و فاشلاً، وله انعكاسات ارتدادية، في أكثر التفسيرات حسنَ نيةٍ. إلا أنها كانت في نهاية المطاف سياقات سياسية، أي أن السياسة كانت لا تزال حينها صاحبة القول الفصْل، حتى في أمور العنف بين اليمنيين. وبالرغم من كل شيء، كان تراكم الدولة والوحدة والجمهورية، وأخيراً الثورة كحلم مشترك في 2011، هي الجدران التي يتكئ عليها عموم اليمنيين بشكل عام.
لكن ما حدث في 21 أيلول / سبتمبر 2014، كان لا يشبه أي شيء آخر، إذ طَرحت سيطرة الحوثيين المسلحة والفجة على صنعاء، أسئلة جوهرية تتعلّق بما بقي ممكناً ومشتركاً بين اليمنيين، من الجمهورية إلى الثورة. لقد عطلت تلك السيطرة السياق السياسي المختل لصالح السلاح. لكن ذلك لم يكن كل شيء. الأكثر صعقاً كان تحالفهم مع علي عبد الله صالح، وقبل استكمال تفاصيل التحالف في كانون الثاني / يناير 2015، للسيطرة الكاملة على السلطة والتمدد جنوباً بقوة السلاح إلى باقي محافظات الجمهورية، في تحالف براغماتي تجاوز كل خطوط المعقول ولغّم اليمن من أقصاه إلى أقصاه، وظل يعلن عن نفسه بأشكال مختلفة، حتى تمخّض في شكله الأخير، مطلع الشهر الحالي، عن تشكيل “المجلس السياسي الأعلى” بين الطرفين.
تحالف الحوثيين مع صالح يشكّل واحدة من أكبر التحولات في المشهد اليمني. فقد كان الحوثيون شركاء أساسيين في الثورة ضد نظامه في 2011. وهم ذوو مظلومية عادلة خلفتها ستة حروب شرسة تحت قيادة صالح ضد صعْدة التي تحوّلت من مدينة السلام إلى مدينة المقابر.. فهي الأكثر عدداً من أي شيء آخر بما في ذلك المدارس والحدائق والمشافي. ومع ذلك، استيقظ اليمنيون في ذلك اليوم، من صعدة إلى عدن، فإذا بأهمّ شريك ورفيق لهم في انتفاضة 2011 قد تحالف مع أهم عدوّ لهم.. في خيانة حتى لشهداء الحوثيين أنفسهم في الحروب الستّة الظالمة ضدّ صعدة. ولّد الأمر شعوراً بالطعن المضاعف لدى عموم اليمنيين، خاصة إذا ما استُحضر الموت الذي صدّرته القوات المشتركة للرجلين (الحوثي/ صالح) لعموم اليمن لاحقاً وحتى يومنا هذا.
هادي والخارج
في الواقع، ومهما كانت المفاجأة التي أحدثها ذلك التحالف بين أعداء الأمس، فذلك لا يعني بأي شكل تبرئة المجتمعين الإقليمي والدولي، وقبلَهما الرئيس هادي، مما جرى وهو المتورط مباشرة في إسقاط عمران وصنعاء. كما هو انخراط دولٍ إقليمية وغربية في الحرب العبثية الدائرة الآن، وهي واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. بل تمّت بشكل أو بآخر المباركة بالقرارات الدولية لكل هذا السقوط نحو الفوضى.
والجزء المهم والفاصل في هذه المعادلة يكمن أيضاً في إدراك الدور المستمرّ الذي يلعبه الرئيس هادي وحكومته (من المنفى حالياً) في خدمة معادلة الحوثي / صالح. فلقد تسبّب الأداء الحكومي الكارثي والضربات المتوالية ضد الشرعية من الرئيس هادي نفسه، إلى فقدان ثقة العالم والمجتمع الدولي بالشرعية وبأي انتصار ضد صالح والحوثي، بل وحتى بقدرته على تحمّل أدنى درجات المسؤولية تجاه المحافظات الخاضعة لسيطرته. فبعد عام من تحرير عدن، لا يزال الرئيس اليمني قابعاً في الرياض، ويتوزّع أعضاء وزارته على الصفحات الإلكترونية والقنوات الفضائية، بينما يدفعون بعموم اليمنيين إلى القتال، منطلقين بهم إلى وجهة غير واضحة المعالم. وفي بداية العام الجاري، قال المبعوث البريطاني – حينها – إلى اليمن، وهو أهم مسؤول غربي في الملفّ اليمني، إن حكومة هادي لم تعُد تمثل عموم اليمنيين!
هذا المؤشر خطير جداً، لأنه يؤسس لتنازع السياسة الشرعية، وتنازع الميليشيات للميدان. هذه الأفعال في كلّيتها ونتائجها هي مؤشرٌ آخر على أن الحرب ليست بين هادي وصالح، وأنهما يخدمان بعضهما البعض. فلو كان الرئيس هادي وحكومته يحاولان عمل أي شيء باتجاه الحسم أو السلام، لكان الوضع العام أفضل بكثير ولعظمت فرص اليمن في إنهاء انقلاب الحوثي/ صالح. هادي هو أهم عجلة تدور عليها دبابات صالح والحوثي في الداخل والخارج.
ما الموقف إذاً؟
إن هذا التداخل الكبير في الأدوار والغايات يزيد من تشوّش الصورة عن اليمن ويصيب الطرق إلى السلام بالضبابية المفرطة. وهو يعقد خيارات الفعل السياسي ومما يمكن عمله. لكن في نهاية المطاف – وأخذاً بعين الاعتبار هذه التراكمات والخلفيات والأبعاد للحرب (والحروب) في اليمن – فإنّ هناك مجموعة من المحدِّدات والخطوط العامة التي يمكن أن ينطلق منها أي موقف وطني أو أخلاقي، وأهم من ذلك أي فعل سياسي في اليمن وبخصوصه. كاتجاه عام، يجب رفض انقلاب الحوثيين وصالح رفضاً قطعياً بصفته انقلاباً وردة سياسية وأخلاقية على جميع ما هو مشترك ومتراكم بين اليمنيين منذ عقود، والعمل بكل الوسائل السلمية والوطنية لتقويضه ورفض نتائجه العسكرية والسياسية الداخلية والخارجية بما في ذلك الحرب السعودية في اليمن. وفي الوقت نفسه، يجب العمل على إنهاء هذه الحروب بكل الوسائل الممكنة وبأسرع وقت بصفتها خطراً عظيماً على اليمن وعلى الخليج نفسه. وأهمّ من ذلك، لأنها حرب تستخدم فيها اليمن واليمنيين، وليست من أجلهم ولا يمكن أن تكون.
استخدمت السعودية القوة الفتاكة في اليمن وقصفت المستشفيات والمدارس والمنازل.. وحتى حلفائها في أكثر من مرة، وفرضت حصارا خانقاً و إذلالاً مدمِّراً بحق اليمنيين (في عملية مشابهة لحصار إسرائيل لغزة) وهو أمرٌ يكشف بأن هذه الحرب لا تجري دفاعا عن اليمن أو اليمنيين. ما يستدعي مجددا رفض هذه القوة الفتاكة ورفض إذلال وتدمير أفقر بلد عربي من قبل أغنى بلد عربي.
وفي موازاة ذلك، يجب العمل من أجل رفض هذه الانقلابات بكل أشكالها، سواء تلك التي يقوم بها الحوثيّون أو تلك التي يرتكبها الرئيس هادي وجماعته. تحرير اليمن من انقلاب الحوثي/ صالح لا يمكن أن يتم إلاّ بعد (أو بالتوازي مع) تحريرها من هادي وطاقمه في المنفى، بصفتهم منتحِلين أكثر من كونهم ممثلين لليمنيين، وبصفتهم خطراً على الجمهورية اليمنية يوازي خطر الحوثي / صالح. ذلك أن وجودهم كفراغٍ في رأس السلطة والسياسة والدولة يخلق فرص الحوثي / صالح: هم جميعاً أدوات في هذا الخراب وليسوا طرفاً في الخلاص منه. ويمكن الدعوة إلى، والعمل نحو، توافق وطني جديد يُنهي الحرب ويؤسس لمرحلة خالية من أوهام الحوثي / صالح ومن أساطير هادي نفسه.
وفي الأخير، يجب إدراك العمل الهادف لمحو الذاكرة اليمنية (داخلياً وإقليمياً ودولياً)، ومواجهة التزوير الممنهج الذي يَدّعي بأن اليمن كان يمر بعملية انتقالية ناجحة. كما أن “العودة إلى ما قبل الحرب الأخيرة” (كما يدعو الخليج وهادي بل وحتى صالح والحوثيين)، هي باختصار عودة لأسس الحرب والخراب في اليمن وليس إلى أي استقرار.
*باحث غير مقيم مركز كارنيغي للشرق الأوسط
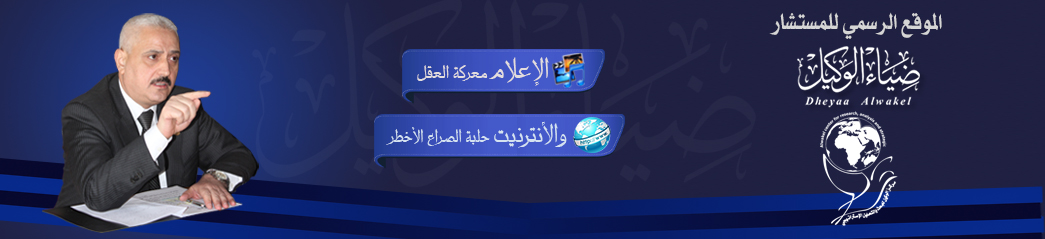 المستشار ضياء الوكيل
المستشار ضياء الوكيل



