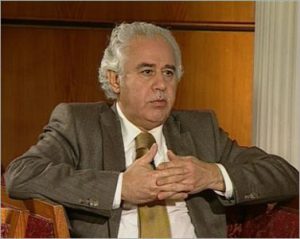
-1-
يوم سقط حسين مروّة مضرّجاً بدمائه وقف مهدي عامل (حسن حمدان) مودّعاً رفيقه أمام ضريح السيدة زينب في ضواحي دمشق قائلاً: إذا لم توحّدنا الثقافة بوجه الظلام والتخلّف، فماذا سيوحّدنا بعد؟ ولم يدر بخلده أنه سيكون الضحية القادمة بعد مرور ثلاثة أشهر فقط، وقد سبقه صحافيان لامعان، هما خليل نعوس وسهيل الطويلة، ونعيد ما قاله مهدي عامل بقلب المعادلة أي جعلها معكوسة: هل الموت هو الذي يوحّدنا أم أن الحياة والثقافة والجمال والتنوّع والتعدّدية واحترام حق الاختلاف والرأي والرأي الآخر هي التي ينبغي أن تقربنا عن بعضنا إن لم تستطع توحيدنا؟
مناسبة هذه الاستعادة هي اغتيال الشخصية اليسارية الأردنية، ناهض حتر في عمّان، على يد أحد المتطرفين الإسلامويين.

لقد وجدتُ في الموت الذي يعني الغياب علاقة وجودية بالحياة، وقد تكون تلك مفارقة، إلاّ أنها مفارقة حقيقية وسائدة، خصوصاً لما يتركه الفقدان من فداحة وحزن يؤثر على مشاعر البشر وعواطفهم، لهذا السبب فهم يبحثون عما يقرّبهم إن لم يكن يوحّدهم، خصوصاً إزاء الأقدار الغاشمة، لكن البشر بطبيعتهم يعودون إلى حيث كانوا، لا سيّما وأن النسيان يجعل مما هو اعتيادي ومستمر قائماً. هكذا إذاً تتفجّر الرغبة والإحساس بما ينبغي أن نكون عليه من تقارب واتحاد ووحدة لمواجهة العبث والموت والفواجع والكوارث.
البحث عمّا يوحّد، كان هاجس الصديق الكاتب والباحث حمادة الفراعنة، الذي وجد في الموت وكأنّه رديف للتوحيد، حين قال إن معاذ الكساسبة، الطيار الأردني الذي اغتاله “داعش” وحّد الأردنيين، مثلما وحّدهم اليوم ناهض حتر، وإذا كان المثقفون يُصدمون عند كل مفاجأة لاغتيال أحدهم، فنتساءل مع الفراعنة، متى يرتقي هؤلاء ومعهم التيارات الفكرية والسياسية إلى ما هو يوحّد، خصوصاً بتحديد الأولويات وتقديم ما هو استراتيجي وثابت على ما هو طارىء وظرفي؟
وإذا كان أول الفلسفة سؤال، كما يُقال، فمن أين نبدأ؟ وكيف ومتى يمكننا تحديد أولوياتنا واختيار جبهة أصدقائنا وخصومنا وأعدائنا بالاتفاق والاختلاف وبالتعايش والمساكنة والمغايرة؟ ثم ما هي المعايير التي يمكن الاحتكام إليها؟
أليس الاتفاق على قاعدة الحدّ الأدنى للخيار الديمقراطي السلمي المدني يمكن أن يكون وسيلة للتفاهم وللمنافسة في آن؟ وهذا يقتضي الاتفاق على أسس وقواعد لما هو مشترك، خصوصاً بنبذ العنف وحلّ الخلافات بالطرق السلمية وإقرار التعدّدية والتنوّع.
وإذا كان الاغتيال السياسي يعني محاولة لإسكات الخصم أو العدوّ أو حتى الصديق إذا كان منافساً أو مختلفاً أو مغايراً، وذلك بتغييبه واستئصاله، فإن الرأي والفكرة والموقف لا يمكن تغييبهما أو استئصالهما أو إسكاتهما حتى عند تصفية مفكّر أو اغتيال مثقف أو صاحب رأي، سواء كان ناشطاً مدنياً أو سياسياً أو رجل دين متنوّر أو صاحب مشروع فكري واجتماعي وغير ذلك.
ويمكن مقارعة الحجة بالحجة، ومواجهة الرأي بالرأي، والفكرة بالفكرة، وليست الرصاصة مقابل الكلمة، وكاتم الصوت مقابل الرأي، والمفخخة مقابل الفكرة، فذلك دليل عجز وضعف وضيق أفق، ولن يحل الاغتيال السياسي محلّ ارتفاع الصوت والقناعة بالرأي، وقوة الفكرة.
إن مسلسل الاغتيال السياسي لن يتوقف، وناهض حتر لن يكون الأخير، لأن قوى التكفير والظلام لا تتورع من استخدام جميع الوسائل للوصول إلى غاياتها، خصوصاً وأنها غير قادرة على المجابهة تحت نور الشمس، إلاّ بالتأثيم والتحريم والتجريم، فتلك وسيلتها باستخدام الدين وتوظيفه لأغراضها السياسية الأنانية الضيّقة، والتي تتعارض مع سياق تطوّر المجتمع، بل ومع سمة العصر، والتقدم الذي حصل على المستوى العالمي.
وإذا قُدر لي أن كنت قد تعرّفت على ناهض حتّر قبل عقد ونيّف من الزمان، والتقيته في عدد من المناسبات، فإنني بتجرد أقول: وجدته مجتهداً وصاحب رأي، وله وجهات نظر يدفع بها ويدافع عنها، ويقبل النقاش حولها، اتفقت أو اختلفت معه، وسواء كان مصيباً أو مخطئاً، فقد وجدت فيه شجاعة في معاكسة المألوف ومعارضة السائد، وأحياناً التحريض عليه بصوت عالٍ وأحياناً بدويّ، فقد كان فضاء الحرّية الذي منحه لنفسه عالياً، مثلما كان التعبير عن الرأي لديه واسعاً، وهو ما يدافع فيه ويكافح وينافح، بالقلم والحرف والصوت والصورة، ودفع حياته ثمناً لذلك.
-2-
وبعد ذلك: ماذا يعني الاغتيال السياسي لمثقف وصاحب رأي ومجتهد، لا يملك سوى قلمه وصوته، وهو بقيمة ناهض حتر، الذي أدانت السلطات الأردنية عملية اغتياله، مثلما أدانتها الأحزاب والقوى السياسية بمختلف تياراتها الماركسية واليسارية والقومية العربية والإسلامية، والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني العربية والعالمية؟ وبقدر ما كان حتر أردنياً، فكان عربياً، وبالقدر نفسه كان أممياً وإنسانياً، يؤمن بتآخي الشعوب وبالمشترك الإنساني وبما يوحّد البشر ويحقّق العدالة والمساواة، وكان مكافحاً شجاعاً يُصارع الحجة بالحجة ويدفع الرأي بالرأي ويطرق الفكرة بالفكرة.
وكان ناهض حتر واضحاً في تصدّيه للفكر التكفيري المتطرّف وللجماعات الأصولية المتعصّبة، مثلما كان ضدّ التدخلات الخارجية من أي ومن أين أتت، سواء باسم مواجهة أنظمة دكتاتورية أو نشر وتعميم الديمقراطية، لأنه أدرك مثل عديد المثقفين أن أي تدخّل أجنبي سيقود إلى تعقيد الأوضاع الداخلية، وينشر الفوضى والتشرذم في المجتمعات العربية، وكان يعرف ما حصل للعراق بعد الاحتلال الأمريكي ويتألّم لذلك، ولا يريد لسوريا أن تكون الضحية المقبلة، ولهذا كان يدعو للانتقال الديمقراطي بوسائل سلمية ومدنية، وبتوفير أدوات مناسبة تهيّىء لذلك، ولن يكون ذلك إلاّ بالإقرار بحق الاختلاف والتنوّع والتعددية، وعبر أسلوب الحوار، وبالضغط الشعبي.
كما كان ناهض حتر يدرك خطر الصهيونية على الأمة العربية ووسائلها الخبيثة في التغلغل الناعم، إضافة إلى آلتها العسكرية العدوانية وحروبها التدميرية، لأنه يعرف أن “إسرائيل” مشروع عدوان دائم ومستمر، وكل عدوان يولّد عدواناً، لأن أساس وجودها واستمرارها قائم على الاستلاب والتوسّع، وهي آخر استعمار عنصري استيطاني في العالم.
وقد بادر بزيارتي في منزلي ببيروت قبل نحو خمسة أعوام، ، ودعاني لتحرّك عربي لمناهضة المشروع الصهيوني، ولا سيّما إعادة الروح إلى “اللجنة العربية لمناهضة الصهيونية والعنصرية” التي كان لي الشرف أن أكون أميناً عاماً لها، وأن يكون الدكتور جورج جبور رئيساً لها، وقد ضمت كوكبة من المفكرين والمثقفين العرب، أو أي شكل جديد يصبّ في هذا الميدان، ولدرء تصدّع البلدان العربية وانتشار الفوضى والتفتّت.
-3-
كنت في العام 1994 قد نظّمتُ ندوة فكرية “بشأن الاغتيال السياسي” في لندن “الكوفة كاليري” في إطار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وكانت المناسبة اغتيال الشيخ طالب السهيل التميمي في بيروت، وقد تابعت خلال السنوات المنصرمة حوادث الاغتيال السياسي البارزة التي حصلت في العالم العربي، وحاولت الكتابة عنها أو الإشارة إليها مثل:
اغتيال غسان كنفاني وكمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار على يد “الموساد الإسرائيلي” في بيروت، وكذلك اغتيال باسل الكبيسي ويحيى المشد عالم الذرة المصري الذي كان يعمل لحساب العراق في باريس، واغتيال خليل الوزير “أبو جهاد” في تونس على يد “الأجهزة الإسرائيلية”، واغتيال ناجي العلي في لندن، ومحمد المبحوح في الإمارات، واغتيال علي شريعتي في لندن، ومحاولة اغتيال مصطفى البارزاني في كردستان، واغتيال عبد الرحمن قاسملو وفاضل رسول في فيينا، والسيد محمد صادق الصدر في العراق.
وكذلك: اغتيال الفنان السوداني الخوجلي عثمان، ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ، واغتيال فرج فودة في مصر، والطاهر جعوط ويوسف فتح الله في الجزائر، وجار الله عمر في صنعاء، ومحمد باقر الحكيم في النجف، وسيرجيو ديميلو ممثل الأمم المتحدة في بغداد، ومئات من العلماء والأكاديميين العراقيين.
وتكرّرت حوادث الاغتيال اللبنانية، فقد اغتيل رفيق الحريري رئيس الوزراء الأسبق، وجورج حاوي، أمين عام الحزب الشيوعي الأسبق، وجبران التويني رئيس تحرير جريدة النهار، والكاتب والإعلامي سمير قصير، ومحاولة اغتيال مي شدياق ومروان حمادة، كما اغتيل في تونس خلال فترة قصيرة شخصيتان بارزتان هما: شكري بلعيد ومحمد براهمي.
أياً كانت الذرائع المستخدمة سواءً سياسية أو فكرية، وأيّاً كانت المبرّرات والمسوّغات، “طبقية” أم قومية” أم “دينية” أم “مذهبية” أم غيرها، وأيّاً كانت الوسائل المتبعة: رصاصة أو سكين أو كاتم صوت أو كأس ثاليوم أو حادث سيارة أو تفجير أو مفخخة أو عبوة ناسفة، أو اختفاء قسري، كما حصل لموسى الصدر في طرابلس (ليبيا)، ومنصور الكيخيا الذي اختفى من فندق السفير بالدقي (القاهرة)، وصفاء الحافظ وصباح الدرّة اللذان فُقدَ أي أثر لهما في العراق، فإنها من زاوية علم النفس الاجتماعي تلتقي عند عدد من النقاط هي باختصار:
الأولى – أنها تستهدف تغييب الآخر وإلغاء دوره ومصادرة حقه.
الثانية – أنها تعتمد على الغدر وإخفاء معالم الجريمة في الغالب.
الثالثة – أنها تتّسم بسرّية كاملة وقد يقوم بها بعض المحترفين.
الرابعة – أنها تستخدم كل الأساليب لتحقيق أهدافها من أكثرها فظاظة وبربرية إلى أكثرها مكراً ونعومة، بحيث يمكن إخفاء أي أثر يُستدلّ عليه من الضحية.
الخامسة – الحرص على إخفاء هويّة المرتكبين وقد يمشي المجرم في جنازة الضحية، الأمر الذي قد تنصرف فيه الأذهان إلى أطراف أخرى، بما فيها قد تكون صديقة أو قريبة، بهدف التمويه ودق الأسافين وإضاعة معالم القضية.
السادسة – أنها تتجاوز على القانونية والشرعية، سواءً كانت الحكومات هي المسؤولة عن تطبيق القانون والشرعية وهكذا يُفترض، فما بالك حين تقوم بعض أجهزتها بالضدّ من ذلك، أو كانت من قوى التطرّف والإرهاب التي لا تعترف بالقانون وبالشرعية، بل إنها تنتهكهما جهاراً نهاراً، ولعلّ ما قام به “داعش” وقبلها “القاعدة” وربيبتها “جبهة النصرة” وأخواتها، ليس سوى محاولة لإلغاء الآخر، بل إنهاء حياته، بهدف إسكاته، وذلك ما استهدفه قاتل ناهض حتر.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن الاغتيال السياسي ومصادرة حق الحياة، هما أسوأ درجات انتهاك حقوق الإنسان، وهما دليل ضعف وليس وسيلة قوة، ولذلك فإن الجهات التي تلجأ إليهما أحياناً، تحاول التنصّل منهما رسمياً أو تنفي مسؤوليتها عن أعمال ترتكب باسمها، بل تحاول خلط الأوراق للتمويه على هويّة المرتكب.
{ باحث ومفكر عربي
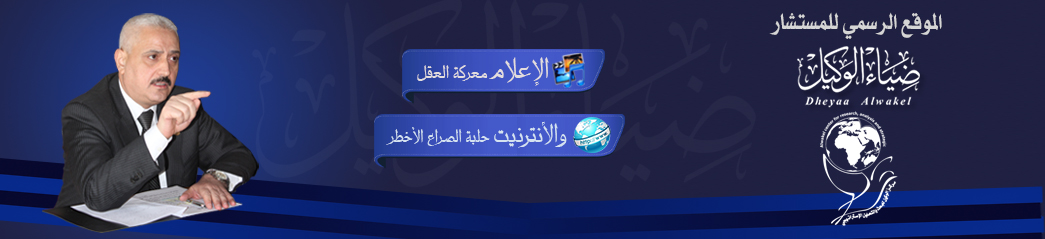 المستشار ضياء الوكيل
المستشار ضياء الوكيل



