


“في 18 نيسان/أبريل، خاطب سونر چاغاپتاي، غونول تول، وأمبرين زمان منتدى سياسي في معهد واشنطن بمناسبة نشر الكتاب الأخير لچاغاپتاي بعنوان، “السلطان الجديد: أردوغان وأزمة تركيا الحديثة“. وچاغاپتاي هو زميل “باير فاميلي” ومدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، وتول هي مديرة مؤسِسة لـ “مركز الدراسات التركية” في “معهد الشرق الأوسط”، وزمان هي كاتبة في “المونيتور” وزميلة في “السياسة العامة” في “برنامج الشرق الأوسط” في “مركز ويلسون”. وفيما يلي موجز المقررة لملاحظاتهم”.
سونر چاغاپتاي
يتتبع كتاب “السلطان الجديد” The New Sultan الاستقطاب الحاد في تركيا من خلال سرد كيفية توطيد رجب طيب أردوغان للسلطة، في البداية كرئيس وزراء ومن ثم كرئيس للجمهورية. فبعد مرور عقد ونصف على تولّيه منصبه، أصبح أكثر القادة الأتراك المحصّنين منذ مصطفى كمال أتاتورك. وفي حين أنّ نصف الشعب التركي معجب به، إلا أن النصف الآخر يمقته. ويضع أردوغان اليوم نصب عينيه رسم تركيا على النحو الذي يريده هو، تماماً كما فعل أتاتورك في الماضي، من خلال توجيه موارد الدولة نحو هندسة اجتماعية في إطار تنازلي [البدء بالمفاهيم العليا ثم النزول إلى التفاصيل] (على سبيل المثال، استخدام سياسة التعليم للتأثير على الأتراك الشباب).
وعلى الرغم من اعتماد أردوغان لأساليب أتاتورك، إلا أن الرئيس التركي لا يشاطر قيم مؤسس تركيا الحديثة. فقد أسس أتاتورك دولةً علمانيةً أوروبيةً ذات طابع غربي، ولكن أردوغان يريد أن تكون دولته شرق أوسطية ومحافظة وإسلامية سياسياً. ويتمثل التحدي في أنه في حين تولّى أتاتورك زمام السلطة كجنرال عسكري، إلا أن أردوغان بحاجة اليوم إلى ولاية شعبية لتصريف أمور الحُكم، على الأقل حتى إجراء الاستفتاء الدستوري في 16 نيسان/أبريل، الذي أدى فيه عدم الإنصاف في بيئة الحملة الانتخابية والمخالفات الواسعة النطاق في عملية الاقتراع إلى طرح علامات استفهام حول ولايته. ولكن بدلاً من أن يثير الشكوك حول النتائج، قرر أردوغان المضي قدماً، معلناً نفسه رئيساً كُلّي القدرة [والنفوذ]. ولن تؤدي هذه الولاية المشكوك فيها إلا إلى تفاقم الاستقطاب الحاد في المجتمع التركي.
ويقول كتاب “السلطان الجديد” بأنه ربما لا يتمكن أردوغان من فرض رؤيته بالكامل نظراً لأنّ تركيا عبارة عن مزيج من الفئات الاجتماعية والسياسية والدينية، التي تعارض نسبةٌ كبيرة منها جدول أعماله. وعلى وجه التحديد، صوّت العديد من سكان المدن الساحلية التركية (التي تمثل أغلبية “الناتج المحلي الإجمالي” للبلاد) ضد هذا الاستفتاء. حتى أن أردوغان خسر في مسقط رأسه إسطنبول، بما في ذلك الحي الذي عاش فيه. وبشكل عام، صوّت ما يقرب من أغلبية الأتراك ضد الاستفتاء، وربما أكثر من ذلك إذا ثبت أن المخالفات الانتخابية المبلّغ عنها كبيرة بما فيه الكفاية. وقد أصبحت تركيا ببساطة متنوعة جداً ديموغرافياً، وكبيرة جداً اقتصادياً، ومعقّدة للغاية سياسياً مما يفوق قدرة شخص واحد على بناء وطن وفقاً لتصوّره الخاص.
فعلى سبيل المثال، على الرغم من الجهود التي يبذلها أردوغان لخلق فئة من الرأسماليين الإسلاميين المقربين، إلّا أن الجزء الأكبر من ثروة البلاد لا يزال مكرّساً لدعم “جمعية رجال الأعمال والصناعيين التركية” (“توسياد”)، المتمسكة بالقيم العلمانية الديمقراطية الليبرالية الأوروبية. وعلى نحو مماثل، ستصبح تركيا قريباً أول دولةٍ ذات أغلبية مسلمة تتماشى مع معايير [برنامج] محو الأمية العالمي، مخففةً بذلك من وطأة التداعيات الساحقة لسيطرة أردوغان على وسائل الإعلام وتفانيه في تكريس موارد الدولة الضخمة لتمويل الحملة “المؤيدة” لمقترحات الاستفتاء، في الفترة التي سبقت هذا الاستفتاء. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما إذا كان بإمكان جناح اليمين التركي الأوسع، الذي يستقطب عادةً حوالي 60 في المائة من الأصوات، أن يوفّر بديلاً عن أردوغان.
ويبدو أن هناك ثلاثة مسارات محتملة أمام تركيا في المرحلة القادمة. أولاً، قد يستمر وضع الأزمة الراهن، ويبقى النصف المؤيد لأردوغان في البلاد معتقداً أنه يعيش في الجنّة في الوقت الذي يشعر فيه النصف المعادي لأردوغان أنه يعيش في الجحيم. ثانياً، إذا أدرك أردوغان أنه لم يعد قادراً على اتباع النهج نفسه في حكمه للبلاد طالما أنها ديمقراطية حقاً، فقد يقرر أن يصبح مستبداً بما فيه الكفاية لإنهاء الديمقراطية في تركيا. ثالثاً، تتمثل الفرضية الأقل احتمالاً في أن يؤدي الانشقاق الداخلي الحاد في البلاد، إلى جانب المزيد من الهجمات الإرهابية التي يشنّها تنظيم «الدولة الإسلامية» و «حزب العمال الكردستاني» أو بالأعمال الشنيعة التي ترتكبها القوى المجاورة كنظام الأسد وروسيا وإيران، إلى جرّ تركيا إلى صراع أهلي.
ومهما كان الحال، فإن دور روسيا كعدو أردوغان يبدو مؤكداً. فدعم موسكو لـ «وحدات حماية الشعب» في سوريا الموالية لـ «حزب العمال الكردستاني» يهدد المصالح الأمنية التركية. أما فلاديمير بوتين، فيعتقد من جهته أنّ نسخة الإسلام السياسي السنّي التي تعتمدها أنقرة يمكن أن تسيّس نزعة التطرف في الأقلية المسلمة في بلاده وتعززها، وهي الأقلية التي تشكّل 15 إلى 20 في المائة من الشعب الروسي وتتمتع بروابط عرقيّة وتاريخية عريقة مع تركيا.
ومع ذلك، فإن احتمال زيادة التوترات بين تركيا وموسكو لا يعني أن تركيا ستعود إلى أحضان الغرب. فقد أصبحت السياسة الخارجية بنداً فرعياً على جدول الأعمال المحلي لأردوغان، حيث صوّب أتباعه سهامهم بشكل رئيسي على الاتحاد الأوروبي في الفترة التي سبقت الاستفتاء. ومن المحتمل أن يمتد هذا المسار القومي المتشدد ليشمل أيضاً تعاوناً أمريكياً مع «وحدات حماية الشعب».
وأظهرت نتائج الاقتراع أن «حزب الحركة القومية» التركي (الذي يعرف أيضاً بحزب « حزب العمل القومي») يشهد انقساماً داخلياً، حيث يتهافت كافة ناخبيه المحافظين في منطقة الأناضول الوسطى وشمال شرق الأناضول من أجل التصويت لصالح أردوغان، إلا أن ناخبيه في المناطق الساحلية والحضرية منشقين فيما بينهم. ولكي يضمن أردوغان الحصول على تأييد مناصريه الدائم في الأناضول الوسطى وشمال شرق الأناضول، من المرجح أن يحافظ على موقف قومي متطرف بشأن قضايا السياسة الخارجية. ومع ذلك، ربما يسعى، على المدى البعيد، إلى إضعاف «حزب الحركة القومية» لكي يحصل هذا الأخير على نسبة تقل عن العشرة في المائة التي تخوله دخول البرلمان.
وعلى صعيد السياسة الداخلية، دعا أردوغان إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام. وإذا حصل ذلك، فسيتم طرد تركيا من “مجلس أوروبا”، مما يعني أن المواطنين الأتراك لن يتمكنوا بعد اليوم من اللجوء إلى “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” للتحكيم في نزاعاتهم.
ولا يزال هناك مساراً رابعاً محتملاً، يتمثل في استبعاد أردوغان، إلّا أنّ هذا المسار يستمد قوته من إنجازات الرئيس التركي. لقد جعل أردوغان تركيا مجتمعاً من الطبقة الوسطى، ولذلك لدى المواطنين حالياً مطالب خاصة بالطبقة الوسطى لكي تصبح تركيا دولةً ليبرالية. ولكن المعارضة لا تزال منقسمةً وتفتقر لزعيم مؤثر. وسيظل مستقبل تركيا مثيراً للقلق إلى أن يظهر من يستطيع أن يعبّد الطريق بشكل فعال لتحويل تركيا إلى دولة ليبرالية، دولة توفر حرية الدين لنصف سكان البلاد وتحرر النصف الآخر من الدين، فضلاً عن الحريات غير المقيدة لجميع المواطنين، بمن فيهم الأكراد.
غونول تول
إن السؤال الأول الذي يتبادر إلى ذهن قارئ “السلطان الجديد” هو: أي سلطان؟ يشير الاستفتاء الذي أُجري في السادس عشر من نيسان/أبريل إلى أنه بإمكان العديد من الأتراك العيش في عهد السلطان سليمان القانوني، الذي كان إصلاحياً، ولكن ماذا عن السلطان عبد الحميد الذي كان بالفعل حاكماً مستبداً؟
ويسدل الكتاب الستار عن مكنونات أردوغان النفسية بطريقةٍ رائعة، ويُظهر عبر إعادة التذكير بخطابات أردوغان، تلك التي يصوّر فيها نفسه على أنه ضحية، والتي يتردد صداها في صفوف ناخبيه وخارجها، الأثر المتبادل بين العقيدة الكمالية المؤسسة للجمهورية وردود الفعل التي تبعتها.
وتمر تركيا حالياً بمرحلة ما بعد العقيدة الكمالية وما بعد الإسلام السياسي، وقد يتوقع المرء أنها ستتبنى القيم الليبرالية كرد فعل على الطابع الاستبدادي للإيديولوجيات السابقة. بيد، لا تطالب الطبقة الوسطى بقيم نابعة من الطبقة الوسطى. وبدلاً من ذلك، تزداد وتيرة الديكتاتورية، ولربما بسبب الطابع المتأصل للثقافة السياسية التركية. وقد ينتقد البعض هذا الأمر ويتخذ منه حجة أساسية، إلا أنه نابع من الخطيئة الأصلية للإيديولوجية الدولانية. فالدولة تحتل مكاناً فريداً جداً في الروحية التركية، إذ غالباً ما يعزى إليها الفضل في تنمية الاقتصاد وإعادة بناء الطبقة البرجوازية. وكنتيجة لذلك، تتماشى الطبقة الوسطى مع سياسات أردوغان الاستبدادية بدلاً من مواجهتها.
وبهذا المعنى، فإن الذين أدلوا بأصواتهم لصالح التغيير الدستوري لم يصوتوا لصالح الاستبداد، بل عبّروا بمنتهى البساطة أنهم لا يمانعونه. إن محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي قد منحت أردوغان هذا الانتصار لأنها أعادت إحياء خطابه الذي يظهر فيه ضحية.
بيد، إن هامش النصر الضئيل يعني أن السياسات الانتخابية ستستمر في لعب دور هام في قدرة أردوغان على تنفيذ جدول أعماله. وتتمثل الاستراتيجية الرئيسية التي اتبعها لإجراء الاستفتاء في تحفيز الشعب على التصويت لصالح القومية، إلا أن هذا النهج لم يحقق نتائج جيدة بشكل تام. ومن المثير للاهتمام أن النتائج تشير إلى أنه قد زاد من دعمه في المنطقة الكردية، الأمر الذي قد يحفزه إلى رد الجميل عبر إعادة تقويم استراتيجيته والعمل مع الأكراد. وقد يكون هذا الأمر بادرة خير على الصعيد الداخلي، ومن المرجح أن يحسّن الأوضاع الاقتصادية والأمنية. كما سيفسح مجالاً أكبر لأنقرة للمناورة في سوريا.
وفي حين أن المعرفة بأن أردوغان زعيمٌ واقعي تمنح بصيص أمل، إلا أنه جلس على عرش السلطة لفترة طويلة حتى أصبح هو الدولة نفسها. ومن المرجح أن تشكّل عملية حقن الإيديولوجيا الدولانية [في عقول الشعب الناجمة عن سياسة أردوغان] حافزاً مهماً على نحو متزايد في صناعة قراراته، وقد يكون ذلك على حساب البراغماتية.
أمبرين زمان
لم تكن نتائج الاستفتاء نهائيةً في أي من الاتجاهين. ونظراً لفرضية فوز أردوغان، فإن النتيجة النهائية تُعتبر السيناريو الأقل سوءاً، إذ أن الأغلبية الضئيلة التي تؤيده لا تمنحه تفويضاً شعبياً للقيام بعمل كل ما يشاء، وهو لا يزال حتى الآن مثقلاً بأعباء مسؤولية الحكم. ولن تدخل الأحكام الدستورية الجديدة حيّز التنفيذ حتى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وبالتالي فإن عدم اليقين من الفترة الانتقالية سيثقل كاهله.
فمن جهة، تشير خسارته في اسطنبول إلى عدم فعالية معينة في قاعدته الشعبية. وبناءً على ذلك، فما أن يُطلب منه مجدداً تولي رئاسة الحزب، من المرجح أن يُجري بعض التغييرات الجذرية، مخلفاً دفعةً جديدةً من الحلفاء السابقين الساخطين. ويمكن لهؤلاء المنبوذين [الذين طردوا من الحزب] أن يتجمعوا حول ميرال أكشنر التي تتحدى قيادة «حزب الحركة القومية» في الوقت الراهن. ولكن، في النهاية، من غير المرجح أن تجتمع القوى المنحازة ضد أردوغان تحت رايةٍ واحدة.
وعلى نطاق أوسع، هناك علامات استفهام جدية تُطرح لأول مرة حول شرعية الديمقراطية التركية منذ الانقلاب الذي حصل عام 1980. وتركّز الصحافة الدولية على التزوير والمخالفات التي حصلت في التصويت على الاستفتاء، وكثيراً ما تشير إلى الانتقادات الصادرة عن “منظمة الأمن والتعاون” في أوروبا.
وفي هذا الصدد، من المرجح أن يمضي أردوغان في استغلال السياسة الخارجية، الأمر الذي لا يبشر بالخير للعلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ولإبعاد الأنظار عن الانتخابات، قد يشرَع في القيام بمغامرات غير مدروسة مثل استهداف تل أبيض في سوريا أو سنجار في العراق. وطالما تولي واشنطن الأولوية في سوريا لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»، ستبقى علاقاتها مع أنقرة متوترة لأن «وحدات حماية الشعب» هي أفضل شريك لتحقيق هذا الهدف.
وهناك مسألة ثنائية هامة أخرى هي قضية رضا ضراب، تاجر الذهب الأذربيجاني الذي يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية، الذي اعتقل لانتهاكه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وفي السابق، كان متورطاً في فضيحة فساد واسعة النطاق اندلعت في كانون الأول/ديسمبر 2013، وقد ذهب البعض إلى حد اتهام عائلة أردوغان بالتورط فيها أيضاً.
إلا أنّ نتائج الاستفتاء هي أيضاً دليل على قوة المجتمع المدني. وعلى الرغم من العوائق الهائلة التي وضعها أردوغان أمام المعارضة، والتي شملت سجن معظم الصحفيين الذين ربما قد كتبوا [مقالات] تعارض الاستفتاء، بالإضافة إلى الآلاف من السياسيين الأكراد، إلّا أنّ فوزه كان ضئيلاً وواجه معارضة شديدة. ويدل ذلك على أن المجتمع التركي يرتقي بتفكيره وأنّ الشعب أصبح يتحمل مسؤولية فردية بدلاً من اعتماده على الجيش لخوض المعركة. ولم ينته الأمر بعد بالنسبة للديمقراطية التركية، بل لا يزال العمل جارياً في هذا الصدد.
أعدت هذا الموجز أويا أكتاس.
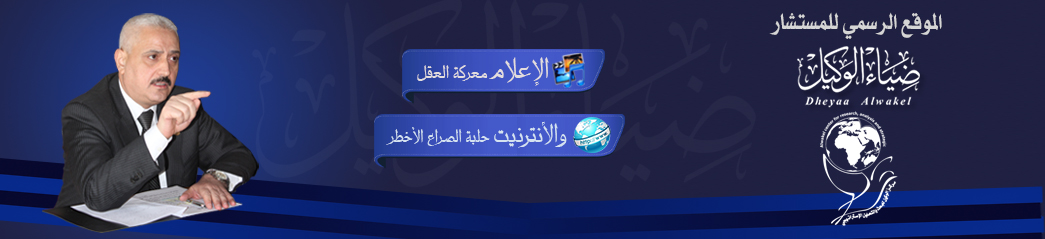 المستشار ضياء الوكيل
المستشار ضياء الوكيل



