
(ترجمة وتحرير: نون بوست)
-بدأت الحركات الاحتجاجية القومية والاقتصادية في الأردن باكتساب زخم كبير، وهي تطالب بتغييرات في سياسات عمان، قد تؤدي لخلافات مع كبار المانحين الدوليين.
-من المؤكد أن أهم الدول التي تقدم المساعدات للأردن، ومن بينها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، سوف تطلب من المملكة اتباع سياسات لا تحظى بشعبية في الشارع.
-هذا التضارب بين الرغبات الدولية والمحلية، يمكن أن يخلق أزمة للمؤسسة الملكية الأردنية، إذا واصلت هذه الأطراف الدولية ضغوطها على عمان.
أثبتت الموجة المتعاظمة من الاحتجاجات في الأردن قدرتها على ممارسة تأثير على سياسات الحكومة. ويذكر أن العقد الاجتماعي الذي ظل قائما في هذا البلد لوقت طويل، صمد بفضل خليط من المساعدات الخارجية، والسياسات الملكية الهادفة لكسب الولاء. ولكن في ظل ما يعانيه الاقتصاد من تدهور، فإن الأردن يواجه التأثير المتعاظم لمختلف الحركات الاحتجاجية. فهنالك من جهة القوميون، الذين يحملون إيديولوجيا معارضة للملك عبد الله الثاني، ويرون أن السياسات التي يتبعها تخدم مصالح الدول المانحة ولا تصب في صالح الأردن. وهنالك في الجانب الآخر المحتجون على الأوضاع الاقتصادية، والذين يواجهون صعوبات متزايدة في كسب عيشهم في ظل فرض إصلاحات هيكلية اقتصادية قاسية، لا سيما تلك المتعلقة بالضرائب الجديدة.
أصبحت المؤسسة الملكية في الأردن منصاعة بشكل متزايد للضغوط الداخلية التي تمارسها حركات الاحتجاج
في الأثناء، تواصل المملكة الأردنية الاعتماد على المساعدات الخارجية، وهو ما يعني أن أبرز الدول المانحة، وهي الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج، تمتلك تأثيرا كبيرا على قرارات الملك. وفي وقت تتضارب فيه طلبات هذه القوى الأجنبية مع رغبات الحركات الاحتجاجية المتزايدة في الأردن، سيكون الملك غير قادر على إرضاء الجميع، وهو ما يعني أن الأردن على الأرجح سوف يتعرض لهزات متواصلة، ومن الممكن أن يشهد أزمة داخلية.
تغييرات صغيرة ولكن هامة
أصبحت المؤسسة الملكية في الأردن منصاعة بشكل متزايد للضغوط الداخلية التي تمارسها حركات الاحتجاج. ومؤخرا، نجح القوميون في دفع الملك عبد الله لإعلان أن الأردن سوف تنسحب من جزء من اتفاقية السلام موقعة في 1994 مع “إسرائيل”، كان من المفترض أن تتم إعادة التفاوض عليه في 2019. هذا الجزء من الاتفاقية، وافقت بموجبه الأردن على السماح لـ”إسرائيل” باستغلال مزرعتين صغيرتين بواد الأردن، في الباقورة وغمر، كخطوة لبناء الثقة بين الطرفين وكحلّ بالنسبة للأردن لتجنب إنفاق المال على مجموعة من المشاريع التنموية في المنطقتين.
إلا أن التزام الملك باتفاقية السلام يبقى راسخا، ولهذا فإن قراره لم يؤد لاندلاع أزمة دبلوماسية مع “إسرائيل”، أو مخاوف بشأن مصير الاتفاقية برمتها. إلا أن هذه الخطوة رغم صغرها تمثل دليلا على محاولات الملك إرضاء بعض الجماعات المحلية التي تعارض جانبا من قرارات الحكومة الأردنية.
في الواقع، فإن هذا الانتصار الذي حققه القوميون يأتي بعد وقت قصير من نجاح المحتجين على غلاء المعيشة، في إجبار الحكومة على إلغاء مشروع قانون ضريبي تم طرحه في يونيو/ حزيران الماضي، وقوبل بغضب شعبي كبير. تلك المظاهرات التي شهدها الأردن في الصائفة الماضية، مثلت أكبر حركة احتجاجات تشهدها البلاد منذ أحداث الربيع العربي في 2011، التي أدت لتشكيل حكومة جديدة بالكامل.
أثناء فترة ثورات الربيع العربي اجتمع القوميون في الأردن مع المحتجين على الصعوبات الاقتصادية، وتمكن التياران من دمج تحركاتهما، لخلق مناخ قابل للانفجار
تلك الاحتجاجات المتنوعة التي شهدتها شوارع الأردن أدت لإحداث تغييرين بارزين في سياسات الحكومة، وهو ما يعكس رغبتها الملحة في إرضاء المواطنين وتجنب كل أشكال الاحتقان. إلا أن هذه التغييرات يمكن في المقابل أن تؤدي لخلافات بين المؤسسة الحاكمة والحلفاء الدوليين، الذين يرغبون بلا شك في استمرار النظام الحاكم في الأردن، ولكنهم يريدون أيضا مراعاة مصالحهم.
مطالب سياسية واقتصادية
أثناء فترة ثورات الربيع العربي اجتمع القوميون في الأردن مع المحتجين على الصعوبات الاقتصادية، وتمكن التياران من دمج تحركاتهما، لخلق مناخ قابل للانفجار. لكن مؤخرا أصبح كل جانب منهما يركز على أولويات محددة لا تلتقي مع مطالب الطرف الآخر. وقد أدت احتجاجات القوميين لإجبار عمان على طرد السفير الإسرائيلي، بعد أن قام حراس السفارة الإسرائيلية بقتل رجلين أردنيين في تموز/ يوليو 2017، وفي المقابل فإن الاحتجاجات الاقتصادية أدت لإلحاق شلل تام باقتصاد البلاد في حزيران/ يونيو، وهو ما أجبر الملك على إلغاء الضريبة على الدخل التي سببت كل ذلك الغضب الشعبي، وتعليق الإجراءات التقشفية التي تم الإعلان عنها.
يلاحظ أن كلتا الحركتين الاحتجاجيتين لا تزالان تركزان على اهتمامات ضيقة، وتفتقران إلى التنظيم، ولكن عدد المشكلات التي تغذي هذه التحركات يشهد تزايدا مستمرا، في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأردني انحداره، وتنهمك المؤسسة الملكية في جهود محمومة وجادة للحفاظ على الاستقرار، من ضمنها اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. وكلما زاد عدد المشاكل التي تثير الغضب الشعبي كلما تزايدت الفرص أمام المتظاهرين لتنظيم أنفسهم. وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن القانون الضريبي الجديد الذي تمت الموافقة عليه جزئيا، والمخطط الأمريكي للسلام في فلسطين، سوف يوفران أرضية خصبة وأسباب إضافية للمتظاهرين من أجل تنظيم أنفسهم في مواجهة المؤسسة الملكية، وتكثيف جهودهم للتأثير على سياسات الدولة.
بالنظر للتحديات الديموغرافية التي يعيشها الأردن، ونقص موارده الطبيعية، فإن محافظته على الاستقرار تعد أمرا مفاجئا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لسوء حظ الأردن، فإن الانتصارات السياسية الأخيرة والمطالب الحالية التي يقدمها القوميون والمواطنون الذين يعانون من صعوبات اقتصادية، أدت لحالة من عدم الرضا لدى الدول المانحة التي تقدم المساعدات المالية للأردن، والتي يعد دعمها حيويا للحفاظ على استقرار البلاد. وقد أظهر المانحون الدوليون أنهم مستعدون لتحقيق أغراض سياسية من وراء تقديم الدعم الذي تحتاجه الأردن بشكل ملح.
المخاطرة بالمساعدات
بالنظر للتحديات الديموغرافية التي يعيشها الأردن، ونقص موارده الطبيعية، فإن محافظته على الاستقرار تعد أمرا مفاجئا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن هذا الاستقرار يعزى في جزء كبير منه إلى دور دول هامة، من بينها “إسرائيل” والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ترى ضرورة في الحفاظ على اقتصاد الأردن وتوفير التمويل الناقص لسد نفقات العقد الاجتماعي القائم. هذه الديناميكية التي تحكم العلاقات بين الطرفين ظهرت بشكل جلي في حزيران/ يونيو 2018، عندما قدمت السعودية والإمارات وقطر قروضا ومساعدات بقيمة جملية تبلغ 1.25 مليار دولار، لمساعدة الحكومة الأردنية على تجاوز المأزق الذي واجهته في ذلك العام. ومؤخرا أيضا، جاء رد الفعل الهادئ من “إسرائيل” تجاه قرار الملك بشأن اتفاقية السلام للعام 1994، ليثبت الحرص الإسرائيلي المتواصل على الحفاظ على الاستقرار في هذه المملكة.
لكن بينما يواصل المحتجون تسليط ضغوطهم على الملك، فإن السؤال المطروح الآن هو حول التأثير الذي سيحدثونه على قرارات المجتمع الدولي. إذ أن السياسات القومية في الماضي دفعت الأردن نحو خيارات ألحقت الضرر بأمنه. حيث أن الملك عبد الله الأول تعرض للاغتيال على يد أحد القوميين الفلسطينيين في 1951، لأنه كان يفكر في إمضاء اتفاق سلام مع “إسرائيل”. وبعده جاء الملك حسين الذي دخل في حرب 1967 ضد “إسرائيل” وخسرها، وهو ما كلف بلاده خسارة الضفة الغربية.
إضافة إلى ذلك فإن رغبة الملك حسين في استرضاء السكان الفلسطينيين في بلاده، جعلته واحدا من زعماء عرب قلائل أعلنوا دعمهم لصدام حسين أثناء حرب الخليج. وهذا الأمر سبب أزمة غير مسبوقة في العلاقات بين عمان وجيرانها الخليجيين، ودفعها للتقرب أكثر من الولايات المتحدة، عبر توقيع اتفاقية 1994 مع “إسرائيل” التي تعد أهم حليف لواشنطن.
من المتوقع أن ضغوط التيار القومي في الأردن سوف تدفع بالحكومة للوقوف في وجه المخطط الأمريكي، الذي يحظى بدعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ودعم آخر أكثر هدوء من قبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان
اليوم يلوح القوميون بالوقوف في وجه الملك عبد الله، بخصوص اتفاق السلام الفلسطيني الذي تستعد الولايات المتحدة لإعلانه (على الرغم من حظوظ نجاحه الضئيلة). ولا تتوفر حاليا إلا تفاصيل شحيحة حول هذا المخطط، الذي قوبل مسبقا برفض كبير من حركة فتح الفلسطينية، في ظل أحاديث عن أنه لن يهدئ من المخاوف القائمة من أن يكون مصير الشعب الفلسطيني هو التهجير الدائم، ولن يضمن لهم الحق الذي لطالما حلموا به بالعودة إلى أرضهم. كما كان قرار واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس، قد عمق مخاوف الفلسطينيين، إضافة إلى أن التحركات الأخيرة التي تنذر بالتعامل مع غزة والضفة الغربية على أنهما منطقتين منفصلتين تماما، تظهر أن واشنطن مستعدة لإقصاء فتح بشكل كامل من مسار السلام.
من المتوقع أن ضغوط التيار القومي في الأردن سوف تدفع بالحكومة للوقوف في وجه المخطط الأمريكي، الذي يحظى بدعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ودعم آخر أكثر هدوء من قبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. إلا أن الدول الداعمة للأردن أظهرت سابقا استعدادها لتعليق مساعداتها لأسباب سياسية، مثلما حدث عندما قررت السعودية والإمارات تأخير تجديد حزمة المساعدات التي انتهت في 2017، وذلك بغرض إجبار الملك عبد الله على تبني مواقفهما السياسية. ولم تقم هاتان الدولتان بالتدخل لدعم الأردن إلا بعد اندلاع مظاهرات ضخمة في حزيران/ يونيو 2018، ودخول البلاد في أزمة.
نيران صديقة
يبدو أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها الأردن، واحتياجها للمساعدات الخارجية، هما عاملان يدفعان بالنظام الحاكم في اتجاهات مختلفة، ويجبران الملك على السير في منطقة وسطى بدأت تضيق شيئا فشيئا. وفي ظل قلة الخيارات المتاحة، فإن الملك عبد الله سيصبح معتمدا بشكل متزايد على مساعدات دول أجنبية، وهو موقف لا يحسد عليه. وعلى سبيل المثال فإن السعودية، سبق وأن اعتمدت سياسات متهورة تجاه حلفائها، على غرار خلافها مع كندا، واحتجازها لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وقد وصل الأمر إلى احتجاز واحد من أثرى المليونيرات الأردنيين، في محاولة لفرض نفوذها. وأي حسابات خاطئة من السعودية أو الإمارات أو كلاهما، سوف تجعل عبد الله معرضا لاحتجاجات كبرى في البلاد.
إضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة يمكن أن تستغل الوعود بتقديم المساعدات، من أجل إجبار عمان على دعم خطة السلام الأمريكية، التي من المؤكد أنها سوف تلاقي رفضا شعبيا في الشارع. إلا أن المساعدة الأمنية الأمريكية تبقى مصيرية للقوات المسلحة الأردنية، والشراكة الأمنية مع عمان أيضا تبقي في غاية الأهمية لواشنطن، ولذلك فإن حدوث قطيعة بينهما يظل أمرا مستبعدا. إلا أن الولايات المتحدة بإمكانها الإبقاء على بعض الغموض بشأن نواياها حول دعم الملك الأردني، وذلك بالاعتماد على البيانات والتهديدات أو حتى التغريدات، وهو ما سيعرض الملك عبد الله إلى المزيد من الاحتجاجات من التيار القومي. وهنالك أيضا “إسرائيل”، التي قد تتسبب بتأجيج المشاعر القومية في البلاد. من خلال حرب أخرى على غزة، أو إعلان الدعم لخطة السلام الأمريكية، أو حتى من خلال حادث آخر مشابه لعملية إطلاق النار في السفارة، وهي كلها سيناريوهات ستعقد أوضاع الملك على الصعيد الداخلي.
من المؤكد أن لا أحد من حلفاء الأردن يرغب في تقويض الاستقرار في داخل هذه المملكة، أو تهديد سلطة حاكمها، ولكن هذه الدول أظهرت أنها مستعدة لانتهاج بعض الطرق من أجل فتح الباب لعدم الاستقرار في الأردن، إذا تجرأت المؤسسة الملكية على عدم الانصياع لمصالحها وفضلت إرضاء المحتجين. واليوم يبدو الأردنيون في الداخل أكثر ضيقا بسبب اقتصاد بلادهم المتداعي والعلاقة مع “إسرائيل”، ولذلك فإن احتجاجاتهم المتزايدة أثرت على السياسات الحكومية. ولكن هذه التأثيرات سوف تخلق تضاربا مع مصالح المانحين الدوليين الذين تعتمد عليهم الأردن كثيرا، باعتبار أنها لا تمتلك ما يكفيها من الموارد للاعتماد على نفسها.
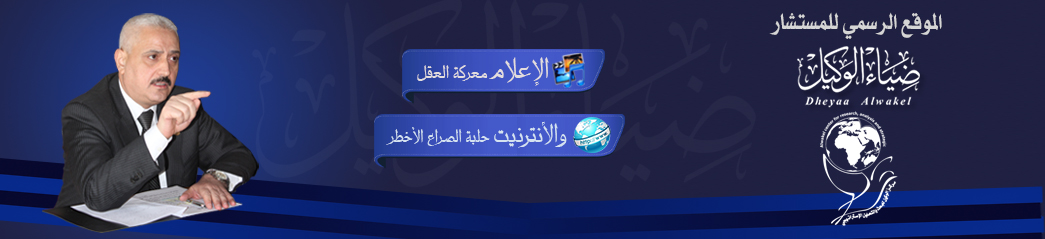 المستشار ضياء الوكيل
المستشار ضياء الوكيل



