
“السلام من أجل الازدهار” عنوان طموح أضفاه البيت الأبيض على “خطته الاقتصادية” من أجل تيسير عملية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي أُعدّت تحضيراً لمؤتمر البحرين الذي انطلق في 25 حزيران/يونيو. هذه الوثيقة التي أُميط اللثام عن مضامينها في 22 حزيران/يونيو أثارت رفضاً واسع النطاق لأنها تطرح رؤية اقتصادية من جهة، لكنها تؤجّل القضايا السياسية الواقعة في صُلب الصراع من جهة أخرى. لذا يرى كثيرون أن هذه المقاربة غير واقعية، وآخرون أنها وخيمة، وآخرون أنها مزيجٌ من الاثنين معاً.

الردّ الصادر عن البيت الأبيض بأن الخطة السياسية ستلي الخطة الاقتصادية، لم يكن مقنعاً أو دقيقاً. واقع الحال أن الخطة الاقتصادية التي أعدّتها الإدارة الأميركية تتضمّن الكثير من الجوانب السياسية. وقد انبثقت الرؤية السياسية بوضوح ليس فقط من رحم التصريحات الصريحة، بل أيضاً من الصمت الثقيل الناطق، وهي ستحمل أبعاداً محلية للفلسطينيين، وأبعاداً إقليمية أوسع.
يتمثّل البعد المحلّي في التعامل مع الفلسطينيين كمجموعة أفراد يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويملكون بعض المؤسسات غير الحكومية والمدنية والإدارية، إنما من دون قيادة أو هوية وطنية. تبدّى ذلك ضمنياً في تصريحات سابقة أدلى بها مسؤولون بارزون في إدارة ترامب، وبات الآن جزءاً لايتجزأ من البرنامج الاقتصادي. ببساطة، لا يأتي هذا الطرح على ذكر منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية أو أيٍّ من الهياكل التي وافق الفلسطينيون على أن تتحدّث باسمهم على المستوى الدولي. وقد أعرب السفير الأميركي في إسرائيل عن ذلك صراحةً حين قال: “لا أعرف أن السلطة الفلسطينية لها الكلمة الفصل في كيفية بناء حياة أفضل للفلسطينيين. ينبغي أن يكون للفلسطينيين أنفسهم رأي في ذلك”.

هذا الاقتراح بأن يكون للفلسطينيين “رأي” لايعني الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة. فواقع الحال أن الرؤية السياسية للخطة الاقتصادية تركّز بشكل كبير على “الحوكمة”، إنما تغفل بالكامل مسألة الديمقراطية. وهي تتضمّن كذلك إشارة إلى “دولة القانون” و”العملية التشريعية”، لكن القوانين تصدر راهناً بموجب مراسيم يقرّها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي لايجرؤ أحد في البيت الأبيض على التفوّه باسمه أو ذكر مكتبه. تشير الخطة الاقتصادية أيضاً إلى المحاكم وحتى إلى “الفصل بين السلطات”، لكن ما من إشارة إلى السلطة التنفيذية الفلسطينية. إذن، يبدو أن رؤية البيت الأبيض لاتعترف للحكومة الفلسطينية بأي سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية تقليدية، بل فقط بهيئات إدارية تُعنى بتوفير الخدمات، فضلاً عن حكومات محلية ومحاكم.
إضافةً إلى ذلك، تنصّ الخطة الأميركية على توفير مساعدات دولية ضخمة لهذه المؤسسات التي لا تملك قيادة وتعمل خارج الأطر الدستورية أو الديمقراطية أو الحكومية. كما تنصّ على ألا يتم الإشراف عليها من خلال العملية الانتخابية، بل من قِبل “المجتمع المدني” والجهات المانحة على الأرجح. قد يعني ذلك ربما وضع الإدارة الفلسطينية تحت شكل من أشكال الوصاية الدولية، لكن من دون أي وصيّ فعلي أو تاريخ انتهاء.
تتألف المساعدات من تعهدات غير دقيقة ومتسرّعة، مقرونة ببعض الاقتراحات المحددة على نحو مدهش، كمطالبة الدول العربية التي لديها جامعات أجنبية مستوردة – كالإمارات وقطر – بتصدير واحدة جديدة إلى فلسطين. باختصار، تفضح العموميات الغامضة والتفاصيل الدقيقة لخطط محددة انعدام الرؤية التام للعقبات السياسية التي عرقلت الجهود السابقة المبذولة لدعم الحكم والإدارة والمحاكم والتعليم والخدمات العامة الأخرى والمجتمع المدني الفلسطيني. في الواقع، لايقتصر غضّ النظر ببساطة على العقبات، فخطة البيت الأبيض الاقتصادية تتغاضى عن وجود أي جهود سابقة، بعضها بُذل منذ ربع قرن أو حتى قبل ذلك.
تستند الرؤية السياسية الإقليمية في الخطة الاقتصادية الأميركية إلى الرؤية المحلية، وهي أن الفلسطينيين ليسوا شعباً بل هم مجموعة الأفراد الذين يعيشون في الضفة الغربية وغزة، وينبغي دمجهم في الدول العربية المجاورة بطريقة تدمج إسرائيل في المنطقة أيضاً. المسألة لاتتمثّل ببساطة في تجنُّب ذكر الاحتلال، بل في جعل الفلسطينيين يستفيدون من قبولهم داخل الترتيبات الإقليمية.
يبدو أن مسؤولي إدارة ترامب، وعلى رأسهم صهر الرئيس جاريد كوشنر، يعتبرون أنه لافائدة من دروس الماضي – فالتاريخ مليء بالإخفاقات. وبالتالي، المثير للسخرية هنا هو إلى أي حدّ تشبه الأفكار الجديدة الأفكار القديمة لكن بحلّة مختلفة. وترقى هذه الخطة الاقتصادية إلى رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز حول “شرق أوسط جديد“، إلا أنها لاتستند إلى إيجاد حل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، بل إلى استبعاد هذا الاحتمال إلى الأبد.
على سبيل المثال، يجري التركيز الآن إلى حدّ كبير على إنشاء بنى تحتية مادية من أجل دعم التنمية الاقتصادية – لكن الآن مع إضافة جديدة، إذ لا يحقّ للفلسطينيين بناء مطارات ولا موانئ – كما اشترطت المساعدة الدولية لتقديم الدعم خلال ذروة عملية أوسلو. بل على العكس، يتعيّن عليهم الاعتماد على جيرانهم، الذين سيحصلون على مساعدات: “بدءاً من تحسين المطارات والموانئ في الدول المجاورة وصولاً إلى تطوير مركز إقليمي لتجارة الغاز الطبيعي في مصر. وسيحسّن هذا المشروع التنقّل في المنطقة ويتيح فرصاً تجارية جديدة أمام القطاع الخاص الفلسطيني”. ويعود إلى الواجهة الممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يؤمّن تنقّل الفلسطينيين – الذي تمّ الاتفاق بشأنه بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين عندما كان كوشنر لايزال مراهقاً – لكن هذه المرة ليس لضمان وحدة الفلسطينيين بل لإذابة الفلسطينيين في المنطقة.
باختصار، لاتعتمد الخطة الاقتصادية الأميركية إلى حدّ كبير على تأجيل القضايا السياسية، بل على افتراض أن هذه المسائل هي من نسج خيال القادة الفلسطينيين الذين أعاقوا ازدهار ورفاه شعبهم. لا يمكن لفحوى الخطة الحماسي هذا أن يحجب حقيقة أنه في ما يتعلق بالفلسطينيين – قادتهم وهويتهم ومصيرهم – وكذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، ما من بند في الخطة يتعارض مع وجهات نظر رئيس الوزراء السابق مناحم بيغن حول الكيان الفلسطيني، التي عرضها للمرة الأولى أمام الرئيس جيمي كارتر في العام 1977.
ربما، إذاً، تتمثّل الإضافة الأكثر جدّة في المقاربة الأميركية في أن إدارة ترامب تطلب من الدول العربية دفع ثمن تحقيقها.
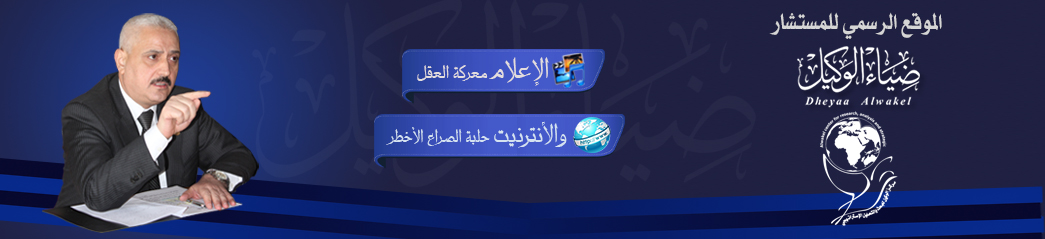 المستشار ضياء الوكيل
المستشار ضياء الوكيل



