شبكة النبأ المعلوماتية: وكالات
ينبغي النظر إلى قرار جامعة الدول العربية إنشاء قوة عسكرية مشتركة باعتباره – أولا وقبل كل شيء – إنجازا كبيرا للسياسة الخارجية السعودية رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أيضا من مؤيديه لكنه قرار ينطوي رغم ذلك على مخاطر جسيمة.
الأمر كله بدأ من الرياض. فبينما كان باديا أن انتفاضات الربيع العربي تكتسح الجميع في طريقها في العام 2011 بدا أيضا أن النظام السعودي يثق بأنه محصن حتى بعد السقوط السريع للرئيس المصري حسني مبارك. ورغم ذلك فقد فضحت سلسلة من الخطوات الفزعة غياب الضمانات لدى القيادة السعودية.
فقد سارع الملك عبد الله – الذي توفي في الآونة الأخيرة – بالظهور على شاشة التلفزيون السعودي معلنا عن زيادات استثنائية في الدعم والأجور وزيادة عدد قوات الأمن وهو ما يعني بالضرورة توزيع مليارات الدولارات على المواطنين السعوديين. وزيادة في الضمان اقترح السعوديون توسيع مجلس التعاون الخليجي ليضم المملكتين الوحيدتين الأخريين خارجه في العالم العربي وهما الأردن والمغرب. وكان الأمر في أغلبه حزمة مساعدات مالية لتكوين قوة من النظم المتماثلة في التفكير والتي يمكن أن تتصدى لتمردات محتملة.
في ذلك الوقت كانت مصر في الجانب الآخر من المعادلة: دولة ثورية تحت النفوذ المتزايد لجماعة الإخوان المسلمين التي لم يثق بها السعوديون في أي وقت.
غير أنه بالقوة العربية المشتركة الجديدة بنت السعودية شيئا أكبر بكثير. ليس فقط بسبب عدد الدول العربية المرجح انضمامها لكن أيضا لأن مصر تعهدت بأن تكون شريكا أساسيا.
ويحقق السيسي الكثير من المكاسب من هذه العملية. إنها يمكن أن تعود عليه بمليارات الدولارات من المساعدات السعودية التي يعتمد عليها وبجانب ذلك تتضمن العملية ترقية دور الجيش المصري الذي جاء منه السيسي. لكن هناك أيضا ما قد يخسره السيسي: فإذا أرسل قوات إلى حرب لا طائل من ورائها في اليمن فربما تعود لتلاحقه مقارنة سعى لتكريسها بينه وبين الرئيس الراحل ذي الشعبية الكبيرة جمال عبد الناصر. وكان تدخل عبد الناصر في اليمن في الستينات فاشلا.
ومع ذلك فمن الناحية التاريخية جاءت أكثر الأعمال العربية فاعلية من خلال تحالف سعودي مصري. فعلى سبيل المثال ربما كانت حرب عام 1973 بين العرب وإسرائيل أكثر الحروب العربية فاعلية في القرن العشرين والتي خاضتها بشكل أساسي قوات مصرية وسورية. لكن السعوديين ومعهم الجزائريون وعرب آخرون لعبوا دورا أساسيا اقتصاديا وسياسيا لأن النفط كان سلاحا أساسيا.
وفي العام 1991 عندما قررت السعودية التعاون مع قوة تقودها الولايات المتحدة لطرد صدام حسين من الكويت تجرأت الرياض على المشاركة بسبب مصر التي ضمنت الولايات المتحدة تأييدها حتى قبل أن تخاطب السعودية. والحقيقة أن صدام حسين قال لمساعديه بعد الحرب إن اللوم يقع على مبارك أكثر مما يقع على العاهل السعودي الملك فهد في التحرك العربي لأن الدكتاتور العراقي كان يعتقد أن السعوديين ما كانوا ليتحركوا بدون مصر.
والآن يواجه السعوديون الحاجة إلى عمل فوري في اليمن. ورغم أن قرار السعودية بأن تلعب دورا قتاليا هو قرار جريء وجديد لا يمكن لأحد أن يهون من شأن التحديات الماثلة خاصة إذا اقتضت الضرورة دخول قوات برية في نهاية المطاف وزادت الهجمات من اليمن على الأراضي السعودية.
وتريد الرياض بالطبع أن تقول إنه صار لها أخيرا دور عسكري. فرغم أن السعودية هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم لا يرى عدد يذكر من الدول أن الجيش السعودي عنصر كبير في التوازن العسكري الإقليمي. والدور العسكري السعودي لم يختبر ولذلك لا تريد الرياض أن تكون وحدها في المعركة سواء سياسيا أو عسكريا.
في الوقت نفسه فإن اليمن ليس سوى جزء عاجل فقط من مخاوف أوسع لدى السعودية تتجاوز بكثير تنافسها الاستراتيجي مع إيران.
القلق السعودي إزاء إيران ليس قلقا عسكريا مباشرا بدرجة كبيرة أو حتى بشأن الامكانيات النووية لطهران. صحيح أن السعوديين لا يريدون أن تصبح إيران قوة نووية لكن أكبر ما يقلق الرياض هو تمدد النفوذ السياسي الإيراني في العالم العربي خاصة في جوارها.
هذه المنافسة -في جوهرها- ليست طائفية. لكنها تفاقم النزعات الطائفية بطريقة تهدد السعودية. السعوديون قلقون إزاء صعود الشيعة العرب الذين تساندهم إيران. لكن الشيء الذي اكتشفوه هو أن الطائفية يمكنها أيضا أن ترعى فئة من السنة يريدون نهاية النظام بدرجة أشد من رغبة بعض الشيعة في ذلك.
وبهذا المعنى فإن مخاوف الرياض في الأيام الأولى من الربيع العربي قد تغيرت. فطموحات الشعوب العربية التي توقفت بعد ما بدا أنها نجاحات مبكرة بالإضافة إلى المآسي المستمرة في سوريا وليبيا واليمن كبحت جماح أولئك الذين كان ممكنا أن يتمردوا بدورهم في أماكن أخرى من العالم العربي. ومع ذلك فإن الفراغ الناتج عن تلك الانتفاضات المعطلة والدول الفاشلة والطائفية المتعمقة منحت الإسلاميين المتشددين مزيدا من المجندين ومهمة حماسية تستهدف الأنظمة الملكية الخليجية كأعداء.
كان تنظيم الدولة الإسلامية جرس تنبيه للسعوديين والعرب الآخرين. ليس فقط بسبب قسوته وتوسعه السريع لكن أيضا لأن تركيز الدولة الإسلامية مختلف كثيرا عما تركز عليه القاعدة التي رغم معارضتها للنظم العربية تستهدف الولايات المتحدة وتعمل بشكل أساسي من أفغانستان بعيدا عن الأراضي العربية. وخلافا لذلك فإن الدولة الإسلامية عازمة على تغيير الأنظمة في الأراضي العربية. إنها تعمل في الفناء الخلفي للسعودية وقد تصبح مشكلة خطيرة على الجبهة الداخلية أكبر بكثير مما يمكن أن يشكله الشيعة السعوديون.
والهدف من القوة العربية المشتركة سياسي جزئيا. فهي توسع نطاق المسؤولية ونطاق اللوم. وهي قد تعطي شرعية إضافية أكبر من قرارات الجامعة العربية التي توقف معظم العرب منذ وقت طويل على أخذها بجدية.
هناك مع ذلك نقطة أساسية وهي أن القوة توفر صيغة لتوسعة العلاقات المصرية السعودية -التي باتت أساسية الآن لكل من البلدين- لتصبح ترتيبا عربيا. وتشكيلها في حد ذاته مهم نفسيا أيضا في وقت بدا فيه العرب عاجزين ومنقسمين وغير قادرين على أخذ زمام الأمور بأيديهم.
بالإضافة لذلك يوجد دور عسكري قد يكون مهما حتى وإن كان محدودا للقوة العربية المشتركة. فمن الصعب تصور -على سبيل المثال- أنها يمكن أن تجابه دولا قوية عسكريا مثل إيران أو إسرائيل أو قوة غربية. إن هدفها في الأساس هو مجابهة التمردات داخل العالم العربي بل وليس كلها أيضا. فمثلا: نظرا لوجود حكومة يهيمن عليها الشيعة في العراق ونفوذ إيران هناك والدور الأمريكي فمن الصعب تصور ظرف يمكن أن يتدخل فيه العرب.
وبالنسبة لسوريا يقع السعوديون بين كراهيتهم لتنظيم الدولة الإسلامية وكراهيتهم للرئيس بشار الأسد. ورؤية الرياض بخصوص سوريا لا تتطابق تماما مع رؤية مصر التي لا تحب الأسد أيضا لكنها تخشى أكثر من انهياره. وانعكس التوتر حول هذا الموضوع في القمة العربية الأخيرة عندما رحب السيسي بخطاب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يؤيد الأسد بينما وجه مسؤولون سعوديون انتقادا حادا له.
ومع ذلك فإن الرؤية السعودية على المدى القصير هي استخدام القوة العربية في الفوضى المتزايدة في اليمن بينما تهدف الرؤية المصرية لاستخدامها في الفوضى المتزايدة في ليبيا. وبالنسبة لمعظم الآخرين خارج مجلس التعاون الخليجي فإن جهود تشكيل القوة العربية المشتركة تتعلق بحصد جوائز اقتصادية وسياسية. وقد يكون هذا كافيا لإنجاحها. لكن من المرجح أن يأتي الاختبار الحقيقي قريبا بما يكفي متمثلا في نتيجة التدخل العربي في اليمن حتى وإن حدث ذلك قبل أن تتشكل القوة المشتركة رسميا.
لكن أكبر عقبة أمام وجود قوة عربية مشتركة فعالة ربما يكون أكبر حتى من الخلافات التقليدية بين العرب: التصدي للتمردات والدول الفاشلة -المشكلة التي أنشئت القوة لمواجهتها- يحتاج لوسائل سياسية واقتصادية أكثر من حاجته للبراعة العسكرية. وكثير من الغضب الذي يعتمل في النفوس والذي أجج الانتفاضات العربية في المقام الأول موجه اليوم إلى كثير من الحكومات التي تقود مسيرة إنشاء قوة عربية مشتركة.
* رويترز، شبلي تلحمي مؤلف كتاب “العالم بعيون عربية: الرأي العام العربي وإعادة تشكيل الشرق الأوسط” ويعمل أستاذا لكرسي أنور السادات للسلام والتنمية بجامعة ماريلاند الأمريكية.
http://ara.reuters.com/
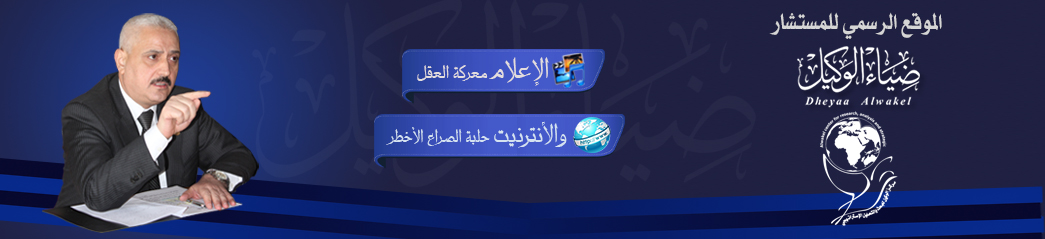 المستشار ضياء الوكيل
المستشار ضياء الوكيل



